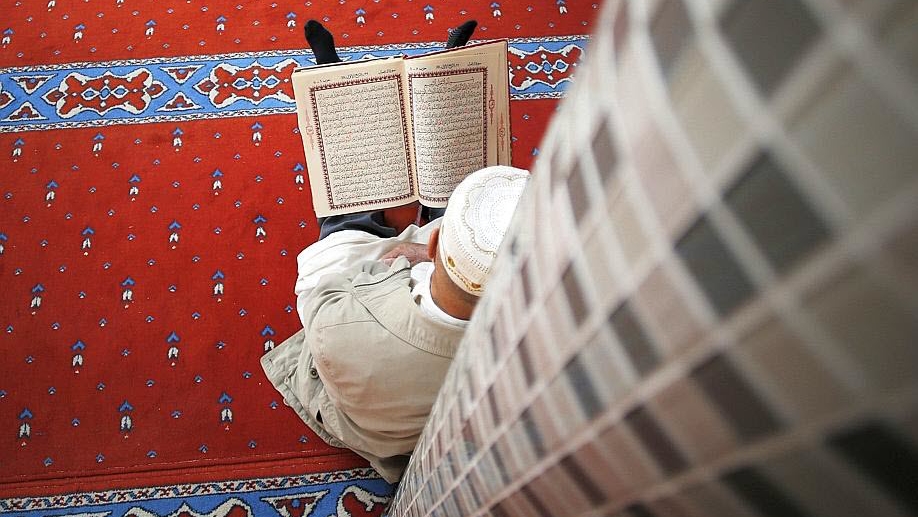حين جاء الإسلام، جعل الحق هو الانتماء؛ فالدين فرض على أتباعه الانتصار له، بوصفه الحق لا بوصفه انتماءً أو حزبًا أو هوية. ولهذا، فإن الفِرَق أجمعها متفقة على أن التقليد يكون في الشريعة لا العقيدة، ومناطه الظن لا اليقين. وأما العقيدة، فالأصل فيها عند كل الفِرق الإسلامية قاطبة هو الاستدلال العقلي الموصل إلى القناعة المطلقة، ولا يُقبل فيها الظن. ولأجل ذاك، كان شرط القناعة يبدأ من المُعجِز الخارق للعادة ولا يقبل سواه دليلًا على صدق النبي في رسالته، صدقًا مُجملًا دون تفصيل.
ولهذا يُروى أنه حين وقع رأس المعتزلة، واصل بن عطاء وجماعة معه، بيد الخوارج الذين كانوا يُحِلّون قتل (الكافر/المرتد)، قال لهم: "إنّا قوم مشركون..."، فأعطوهم الأمان بموجب أصول العقيدة: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ) (سورة التوبة: 7).
الدين يبدأ بالمعجِز، ليكون دليلًا على العقيدة، ولا يُقبل في العقيدة النقل والنص، على استثناء الحنابلة - وقد أنكر ابن التلمساني أن يُنسَبوا لابن حنبل، وأصرّ على تسميتهم بـ "الحشوية". ولهذا قال شارح معالم أصول الرازي: لو قلدتَ في الإيمان، فما أدراك أنك قلدت مُحِقًّا؟ فإن قلتَ: بالكتاب والسنة والإجماع، يُرَد عليك: بأنه لا يُستدل على النقل بالنقل. ومما يُنسب إلى عمرو بن عُبيد أنه قال: "الله لا يضُرّ ولا ينفع". هذا عمرو بن عُبيد الذي قال فيه الحسن البصري: "سيكون له شأن إن لم يحدث". هو عمرو المعتزلي الذي نُقل عنه أنه سمع حديث الصحيحين في مسألة خَلق الإنسان، الذي منه: {ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِرِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ؛ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا}. فأنكره حين سمعه، ولم يقبل بصحته. وقال: "لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب ما أجبته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من الرسول لرددته، ولو سمعته من الله تعالى، لقلت له: ما على هذا أخذت ميثاقنا". وقد رُوي عن زهده وتقواه والإشادة بخلقه أخبار كثيرة. وأما ما يُحكى عن ضلاله فهو من باب الخلاف والتحزب لا من باب الدين. وإلا فإنه قد نُقل عن ابن حنبل أنه قال في أبي حنيفة: إنه لا يُؤخذ برأيه. وقال فيه مالك بن أنس: إن فتنة أبي حنيفة على الأمة أشد من فتنة إبليس من وجهين: الإرجاء ونقض السنة بالرأي. بل إن الزاهد المعروف ابن المبارك كان يكنيه بـ "أبي جيفة". وهذا الجاحظ إمام النثر العربي غير منازع، وبإقرار أعتى خصومه، يصف ابن حنبل بالكذب والوقاحة والعي. الجاحظ الذي قدّم خلاصة بيانه في الدفاع عن نبوة محمد (ص)، وإعجاز القرآن. وهو الجاحظ ذاته الذي يكتب في النساء والعشق والغناء والموسيقا؛ هو الجاحظ الذي يقول: "فتأملنا شأن الدنيا، فوجدنا أكبر نعيمها وأكمل لذاتها ظفر المُحِبّ بحبيبته، والعاشق بِطُلْبته". وهو الذي يتحدث عن أن الحبيب لا يمكن أن يصرفه صارف عن حبيبته ولا أن يدع "التشاغل بشمها ورشفها واحتضانها، وتقبيل قدميها، والمواضع التي وُطِئت عليها" (حتى إن المحقق ابن القرن العشرين، لم يشرح العبارة التي قالها ابن القرن الثاني للهجرة وإمام نثرها).
لقد بدأ الإسلام نشاطًا خلّاقًا، لكن السياسة والتحزبات خلقت طبقة من الكهنوت المُضلِّل الذي حاك صورة مزورة عن ديننا وتراثنا من جهتين: الأولى: قداسة الرجال، والتاريخ يقول: إن صفاء هذا الدين كان بعيدًا عن هذه القداسة. وأما الأخرى فضيق الدين أو تضييقه، وذات التاريخ يقول: إنه كان أوسع من كل واسع.
ولقد كانت السياسة هي مقتل الفكر الديني، وكان أول حصادها أقربه إليها؛ فلما اقتربت المعتزلة من بلاط الخلافة وتحالفوا، وصار الدين دولة وإجبارًا، وسُنّت لأجله بدعة السيف والقهر، لمّا حصل ذلك، كان الاعتزال أول ضحاياه؛ فقد كاد يندثر هذا الفكر بعد أن جافاه السلطان، وخاب ظن الناس فيه، والأهم ما أحدثوه من خيانة نهجهم العقلي الخلّاق الذي نحا نحو التقييد والفرض.
وجاءت عصور التحجّر والانكفاء، والتجهيل والتزوير، لتجود بطبقة من فقهاء الورع العقلي مقابل التألّه الأخلاقي وتزييف الوعي؛ فصرنا أقرب إلى "الارتزاق والعهر الفكري"، وصار "الدين تراثًا والتراث دينًا" كما يقول حسن حنفي. وموّهوا علينا ديننا فأحاطوه بهالة من التمذهب والتفاسير، لتصير هذه الهالة حجابًا بيننا وبين صفائه ونقائه ومنبعه. ويكفي أن نستشهد من تراثنا المتأخر، الذي صار دينًا، بما يرويه لنا ابن خَلِّكان المُحدِّث والقاضي والمؤرخ، عن أن شيخه المُحدِّث الأصولي ذائع الصيت (ابن الصلاح) كان أراد أن يدرس المنطق سرًّا على يد الفقيه الشافعي والرياضي المنطقي المتبحر في علوم زمانه (كمال الدين أبو الفتح)؛ وبعد أسابيع وجد نفسه عاجزًا عن استيعاب هذا النوع من العلوم وهضمه. ولما لاحظ الأستاذ تعبه، نصحه بالرجوع إلى الحديث وأصوله، وقال له: "يا فقيه، المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن". فقال له: "ولِمَ ذاك يا مولانا؟" فقال: "لأن الناس يعتقدون فيك الخير، وهم ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد؛ فكأنك تفسد عقائدهم فيك". علمًا أن ابن الصلاح سُئل مرة عن شيوخ كمال الدين أبي الفتح؟ فقال: "هذا الرجل خلقه الله عالِمًا إمامًا في فنونه، فلا يُقال على من اشتغل ولا مَن شيخُهُ؛ فإنه أكبر من هذا". هذا الرجل الذي كانت تُشَدّ الرحال لأجل التلمذة له؛ وقد ذُكر أن الفقيه المصري (علم الدين قيصر بن مسافر الحنفي- المعروف بتعاسيف) قد يمّم قصده، من مصر إلى الموصل ليدرس على يديه: (الموسيقا). وحين وصله وعرف قصده وبغيته الموسيقية، قال له الشيخ: "مصلحة هو [يقصد فن الموسيقا]، فلي زمان ما قرأه أحد عليّ، فأنا أوثر مذاكرته وتجديد العهد به". وقال علم الدين: "فكنت عارفًا بهذا الفن، لكن كان غرضي الانتساب في القراءة إليه".
لقد كان في سقوط الدولة العباسية سقوط للعقل العربي-الإسلامي في براثن الوَهَن والاندحار الإبستمولوجي. سقوط سبقه تعثّر وتراجع منذ زمن الخليفة العباسي الثامن: (المعتصم) الذي لم يكن يُحسن من العلم والمعرفة ما كان عليه آباؤه، وظنّ أن اعتصامه بقوّة بأسه وشجاعته يحميه ويحصّن دولته، فصار لُعبة النخبة المحيطة به ثقافيًا، وفريسة التسلح بالأعاجم الذين أخذوا الدولة شيئًا فشيئًا. وظل العقل العربي يسابق انحدار دولته، حتى كان السقوط الكامل. سقوط صار النهوض منه أصعب من نهوض الدولة وأعقد. وظل هكذا حاله إلى أن جاء زمن المد العثماني؛ فكان بمثابة موت لهذا العقل ولِذِهنه. وصرنا نعتاش على فكر الأقدمين وكأنه قرآن وحَدٌّ من حدود الشريعة، وسحق لنا بعدًا عن جوهر الدين والثقافة العربيتين. فكان التخلف والجهالة وتفتت الروح العربية عوامل استغلها تجار الدين ومُرتزقة الظلام، فدلّسوا علينا أن المقدس ليس الله وحده، ولا نبيه معه، وإنما هو كل ما يتصل بالدين بنسب. وأوهمونا أن الاجتهاد وإعمال العقل ضلالة وانحراف. وكذبوا إذ صوّروا الفقهاء وأصحاب الأصول ملائكة في أخلاقهم ومُلهمين في علمهم، وحكماء في نهجهم، وأنْ ليس هناك اجتهاد وخلاف وتنافس وتنازع وتباغض وتحاسد كما هي حال البشر، وإنما هناك فقهاء حقٍّ وأصحاب بِدَع وأهواء وضلال وباطل، والأمر ليس اختلافًا بل هو خلاف وحرب. فأمسى الجهل حاجزًا يحول بيننا وبين الشجاعة الفكرية والعقلية التي كانت لأسلافنا، أو كما قال أمير الشعراء:
إن الشجاعة في القلوب كثيرة / ووجدتُ شـجعان العقول قليلًا
إننا - العرب - ما نزال نعيش في ماضينا، ونجتر فكر أسلافنا الذين عاشوا حاضرهم منقطعين فيه عن فكر ماضيهم، من دون الانفصال عن ثقافة ماضيهم وبيانها ومعارفها؛ أخذوها مادة يملؤون بها قوالب فكرهم الجديد بحسب حاجته واستيعابه ونمط تشكيله. وأما نحن مازلنا أسرى فكر الماضي الذي مضى زمانه ولمّا يزل زيًّا نتزيّا به. وقد خُلق الإنسان وصَنَع حضارته على سُنَن كونيّ معروف: هو لكل زمن فكره المتجدد دومًا، وثقافته التي يتواصل فيها الماضي بالحاضر؛ فالفكر يتجدد والثقافة تُحفظ وتتراكم، مَثَلُ ذلك مَثَلُ الزي الذي يتجدد بتجدد الأزمان؛ وقد قيل: "لكل زمن لَبُوسُها". وإن ظلت مادته وقماشه محفوظة مُعادة ومُضاف إليها.
ولا غرابة في عودتنا إلى تراثنا وماضينا؛ فهذا عُرف بشري ثقافي مستمر؛ "والمجتمعات المأزومة، كما يُعلّمنا التاريخ [كما يقول عبدالإله بلقيز]، هي أكثر المجتمعات عناية بماضيها، بإعادة الانتباه إليه، وإعادة التفكير فيه وقراءته، عساها تعثر فيه عن أجوبة ناجزة، أو عن خامات قابلة لتصنيع أجوبة، عن مشكلات حاضرها، [بواسطة] قوى مُهيمنة تفرض هيمنتها باسم ماضٍ تخلع عليه أردية من التقديس". بيد أن مأساة راهننا المعاصر أن نستعير فكر الماضين، لنملأه بثقافة حاضرنا واحتياجاتنا وحياتنا. ثمّ نأخذ من تراثنا أكثر القوالب نفعية وصلاحية للارتزاق وطمأنينة المعهود.
قال الأصولي الفقيه ابن التلمساني، ردًا على مُنكري علوم المنطق والكلام، الذين قالوا: (إن جيل الصحابة لم يعرف: الجوهر الفرد، الأعراض، الصفات، التوليد، الاكتساب، التجوير، والطفرة، والطبائع، الحيّز، والخلاء، والمكان... من ألفاظ المناطقة والمتكلمين، فقال: والصحابة- أيضًا- لم يعرفوا: الجرح والتعديل، المرفوع والمرسل، الواجب والندب). نعم، الماضي ثقافة والدين مادة قابلة للحياة في كل زمان، لكن الفكر ابن زمانه ومستجداته. أو بحسب التعبير الأصولي الأشعري: التراث جوهر ثابت، والفكر عَرَض مُتغير باستمرار. نعم، لنا ماضينا؛ فهو تراثنا تَرِكَةً منهم، وليس لنا فكرهم؛ لأنه لهم وروح عصرهم الذي يغادر الدنيا بذهابهم. فيصح قولنا: (ماضينا)، إشارةَ أصالة واتصال، ولا يصح قولنا: (فكرهم)، إلا إشارة عجز وافتعال. هي اللغة تُرشدنا إلى الاستعارة الصحيحة، حين يعجز عقلنا عن تمييزها من المقلوبة، والرشد إليها: (ماضينا) يشملنا ويشملهم، و(فكرنا) لا يكون إلا دلالة علينا وعلامة.