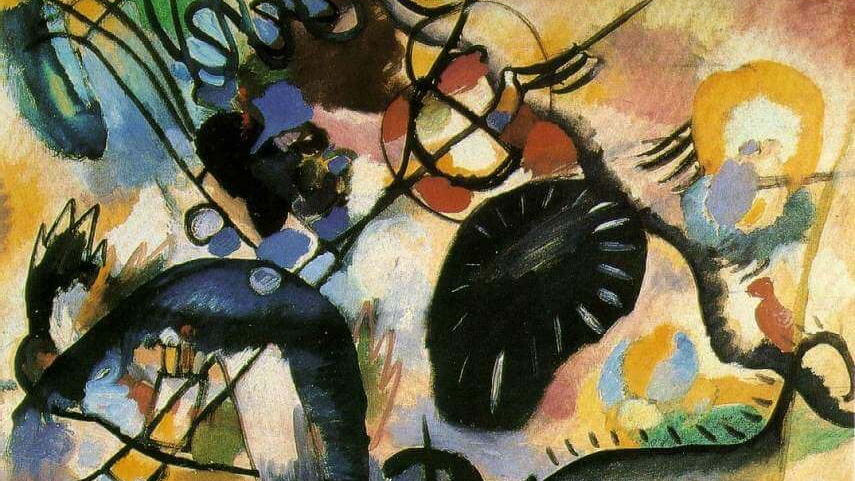مقدمة أولى وأسئلة في محاولة إعادة صياغة تعريفات معروفة:
إذا كانت الشجاعة مفهوماً نبيلاً، فإنها ليست كما تُقدّم في الحكايات البطولية. طالما أنها ليست درعاً لامعاً، ولا سيفاً مسلولاً، بل وجهاً متعباً للصدق، يمشي فوق حافة الخطر. إذ كثيراً ما نخلط بينها وبين التهور، بين وعيٍ عميق بفعلٍ أخلاقي، ورغبةٍ جامحة في كسر القيد لأي سبب. هذا الخلط ليس بريئاً. إنه أحياناً آلية دفاع نفسي، تُخفي وراءها خوفاً من مواجهة الذات، أو حاجة لتسويغ قراراتٍ اتُخذت في لحظة انفعال.
حين كان الامتحان حقيقياً فإن الشجاعة لم تكن شعاراً البتة. لقد كانت موقفاً. كما أن "لا" لم تكن تنبثق في لحظة عارية من كل حماية، مواجهة مباشرة للخطر، لا تسندها إلا شجاعة صاحبها. هناك، في الوطن، ظهرت الشجاعة بأبسط صورها وأكثرها فتكاً: نظرة في عين الجلاد، وقولٌ لا يُسند إلا باليقين. لكن تلك اللحظة انقضت. انتقلنا إلى المنافي. وصار السؤال: أين تُختبر الشجاعة الآن؟
ولطالما ظهر السؤال التالي: كيف نزن نبرة الكلام حين تنتزع من محيطها المهدِّد، وتوضع في فضاءٍ لا يترصّدها فيه أحد؟ حيث إنه في غياب شرط الخطر المباشر، تنشأ الحاجة إلى إعادة تعريف الموقف الشجاع. وهو ما يدفعنا لمواصلة الأسئلة: هل تُختبر الشجاعة في بث فيسبوكي استعراضي؟ أم في نصٍ مدون غاضب؟ أم في منشور يُصنّف الآخرين؟ أهي تكمن في الشتائم الموجهة إلى المختلف معهم؟ وهل من شجاعةٍ في مهاجمة من يشبهك في الجرح؟ من تقاسم معك المغترب أو الزنزانة، أو تفاصيل النزوح، أو الخوف؟ إذ يمكن لأخس جبان أن يستتفه أعظم بطل في العالم، وهنا أتذكر حكاية لوالدي - رحمه الله - طالما رواها لنا، على سبيل التندر، مفادها أن شخصاً "جباناً"، وكلمة "جبان" مضافة من قبلي، قال في مجلس كان يضمه وآخرين في ستينيات القرن الماضي: آه، لو التقيت الرئيس (فلان)، في صحراء، ومعي عشرة رجال يرمونه أرضاً، بعد أن يربطوه لي، وأن تكون في يدي بندقية، كي ألقنه درساً...!
مؤكد أنه في زمنٍ فقدَ امتحانه الحقيقي، باتت تتسلل علانية – بل بوقاحة – أشكال مزيفة من البطولة. إذ تتبدل الشجاعة أحياناً إلى ضجيج متوتر داخل جدرانٍ مطمئنة، حيث لا يمسّك خطر حقيقي. ويتجسد خيال أو تخيل "العدو" في القريب، لأن البعيد محصّن، بعيد، وقد لا يستمع أو لا يكترث. وهكذا، تُجرّ المعركة إلى الداخل. وتُختزل البطولة في معارك جانبية: شتائم، تصنيفات، محاكمات شعبية، لا في مواجهة الاستبداد، بل في تقطيع ما تبقى من جسد المنفى. وما أكثر الذين حين يفقدون عدوّهم الحقيقي، ليبحثوا عن عدو وهمي افتراضي بديل يسوغ استمرار حالة التأهّب في دواخلهم.
الشجاعة، كما أراها، ليست إنكاراً للخوف، بل عبوراً من قلبه، كما لو كان جسرًا لا سبيل لتجاوزه إلا باجتيازه. ليست إعلاء الصوت في المساحات الآمنة، بل صدى القلب في مواجهة المجهول. أما التهور، فهو اندفاعة عمياء، كمن يركض بلا بوصلة في عاصفة. وغالباً ما يكون نتيجة جروح غير مفهومة، رغبات دفينة بالانتقام، أو حاجة لإثبات الذات أمام مرآةٍ داخلية متصدّعة، وهو ما يستدر الشفقة والحاجة إلى العلاج.
ومن هنا، يمكننا السؤال:
كم من تصرفاتنا الثائرة اليوم، تنتمي إلى اللاوعي أكثر مما تنتمي إلى القيم؟
كم مرة صرخنا، لا لأننا نؤمن، بل لأننا نخجل من صمتنا السابق؟
كم منّا يتحرّك بدافع: "لم أفعل ما يكفي"، لا بدافع: "هذا هو الصواب"؟
وكم نصنّف الآخر، لا لنُعرّفه، بل لنستكين أمام وضوح هويتنا الهشة؟
ولهذا كله فإن الشجاعة، كما كل فضيلة، لا تختبر في الفراغ. بل إنها فعل يتطلب سياقاً، خطراً، اختياراً صعباً. واليوم، في أوروبا، في فضاءٍ آمن، منظم، القانون فيه يحمي جميعنا، أين هو هذا الخطر؟ أين هو الامتحان؟
ربما الشجاعة اليوم لم تعد في المواجهة التيكتوكية أو الفيسية أو اليتيوبية أو التويترية، بل في الاعتراف. الاعتراف بأن الزمن تغيّر، وأن البطولة لم تعد ممكنة بالطريقة ذاتها. الاعتراف بأن من نجا ليس هو بالضرورة بطلاً، ولا جباناً. فقط هو مجرد ناجٍ. يحمل ذاكرةً ثقيلة، وجسداً مرهقاً، وأسئلة معلّقة.
ربما الشجاعة الآن تكمن في أن تصمت حين يسهل الكلام، أن تبني حين يسهل الهدم، أن تداوي بدل أن تدين. أن تمد اليد مقابل من يرفع يداً افتراضية!
أن تميّز بين الحاجة إلى التفريغ، والحاجة إلى الإصلاح.
أن تسأل نفسك: لماذا أصرخ؟ من أهاجم؟ ما الذي أبحث عنه؟
ما الذي يعيدني إلى جبهةٍ صُنعت على الورق، في حين ساحة المواجهة الكبرى قد غادرتني؟
ربما الشجاعة هي أن تعيد تعريف الشجاعة ذاتها، كلما تغيّر الزمن.
الشجاعة امتحانها هناك، في الوطن. لكن شجاعةً أخرى تُطلب هنا: شجاعة مواجهة الذات في غياب المعركة.
شجاعة الاعتراف بالضعف، وبالرغبة في الهدوء، بعد كل هذا الصراخ.
شجاعة أن تبدأ من جديد، لا لأنك انتصرت، بل لأنك لا تزال حيّاً.