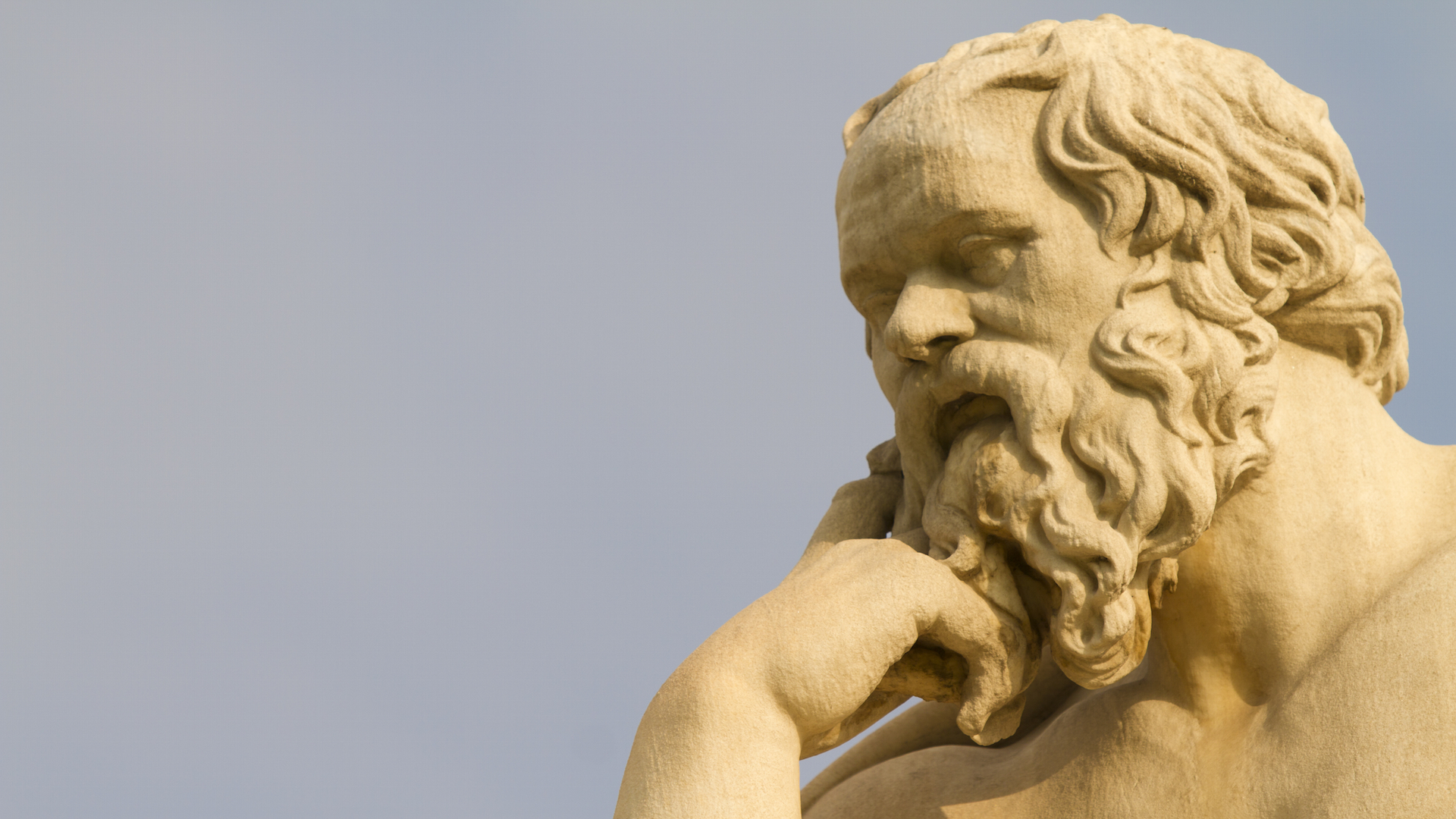الكلمة الحق في النقد تظل محفوفة بالمتاعب والمخاطر. ليست هذه المتاعب طارئة ولا عارضة، بل هي جزء لا يتجزأ من طبيعة الكلمة نفسها، لأنها حين تُقال بصدق تخلخل السكون الزائف، وتوقظ ما أراد الناس أن يبقى نائماً في الظل. فالحق دائماً موجع، موجع لأنه يقف في مواجهة الأكاذيب التي يطمئن إليها البشر، ويقتحم الأسوار التي شيّدوها حول أوهامهم كي يظنوا أنهم في مأمن.
إنَّ الذين يقولون الحق يعرفون مسبقاً أنهم سيدفعون ثمناً. والثمن ليس دوماً في صورة عقوبة جسدية أو قانونية فحسب، بل قد يكون عزلةً اجتماعية، أو فقدان فرصٍ، أو حتى نظرات الشك من أقرب الناس. ومع ذلك، فإنّ عظمة الكلمة لا تظهر إلا حين تُقال في ظرفٍ يضيق عنها، فتأتي كشقّ في جدار صلد، تدخل منه نسمة حرية أو شعاع وعي.
النقد، بصفته أداة للكشف والتمحيص، ليس ترفاً ذهنياً، ولا لعبة فكرية يتلهّى بها من يملكون فائض وقت. إنه فعل وجودي، وموقف أخلاقي، وبُعد حضاري. لذلك كان الذين انشغلوا به منذ القدم، من فلاسفة ومصلحين وكتّاب وشعراء، قد دخلوا في مواجهة مع محيطهم، لأنهم قرروا أن يحملوا مشعل الضوء وسط عتمة الرضا بالتزييف.
إذا تأملنا طبيعة النقد، وجدناه أشبه بالعمارة. ليست جدراناً وحجارة فحسب، بل رؤية تنبني على فهم للمكان والزمان والوظيفة والجمال. كذلك النقد، حين يُبنى، يحتاج إلى أساس من معرفة صلبة، وإلى أعمدة من شجاعة، وإلى نوافذ تفتح على أفقٍ أرحب من اللحظة الراهنة. وكما أنّ المعمار قد يُشيَّد ليُبهر أو ليخفي قبحاً ما خلف واجهة أنيقة، كذلك النقد قد ينحرف إلى المديح أو التزييف إذا فقد جوهره الأخلاقي.
إنَّ المدن التي عرفتها البشرية تحمل في شوارعها تاريخ النقد أيضاً. فبين جدران أثينا كان سقراط يتجول، يسأل ويفكك، حتى انتهى به الأمر إلى كأس السم. وفي أزقّة بغداد العباسية كان الجاحظ يكتب مقالاته التي تهزّ القناعات السائدة، ساخراً أو محللاً أو مفسراً. وفي مقاهي القاهرة والنجف ودمشق كانت الكلمة تُقال خافتة أحياناً، صارخة أحياناً أخرى، لكنها دائماً محكومة بالوعي أنّ من يقول الحق عليه أن يستعد لدفع ثمنه.
النفس البشرية بطبعها لا تحب أن تُعرَّى. الإنسان يُفضّل أن يُرى في صورته المثالية، تلك التي يبنيها عن ذاته أمام الآخرين. وحين يأتي الناقد ليكشف التناقض بين الصورة والواقع، بين القول والفعل، فإنه يجرح كبرياء دفيناً. وهنا يكمن جوهر "وجع الحق". ليس الوجع في الكلمة ذاتها، بل في ما تثيره من صراع داخلي، بين ما نعرفه عنا في أعماقنا وما نريد أن نعرضه للناس.
النقد، بهذا المعنى، ليس سجالاً فكرياً فقط، بل هو عملية نفسية عميقة. هو كمن يمسك مرآة صافية في وجه أحدهم، فيرى هذا الشخص ملامحه بلا رتوش. قليلون هم الذين يحتملون مواجهة صورتهم كما هي. أما الأغلبية، فيختارون كسر المرآة بدل أن يعترفوا بما تعكسه.
المجتمعات، عبر التاريخ، لم تُرحّب غالباً بالنقد. لأنها بُنيت على توازنات من مصالح وسلطات وأعراف، وهذه كلها هشّة بطبيعتها. الكلمة الناقدة قد تهدّد هذا التوازن، فتصبح خطراً على السلم الزائف الذي يريده الناس. لذلك لم يكن مستغرباً أن نقرأ في التاريخ عن محاكم التفتيش التي طاردت كل مفكر حر، وعن السجون التي امتلأت بأصحاب الرأي، وعن المنافي التي ابتلعت شعراء ومبدعين.
لكن، وعلى الضفة الأخرى، فإنّ الحضارات التي نهضت لم تبلغ ذروة قوتها إلا حين فتحت صدرها للنقد. أوروبا التي خرجت من عصور الظلام لم تتقدم إلا حين تحمّلت وجع فلاسفة عصر التنوير، وروسيا لم تعرف أدبها العظيم إلا بفضل أولئك الذين كتبوا عن بؤس الإنسان ومعاناته في مواجهة الطغيان، والعالم العربي نفسه لم يعرف لحظاته المضيئة إلا حين وُجدت أصوات صادقة كسرت جدار الصمت.
إنّ العبارة "على من يقول الحق أن يدفع الثمن" تحمل في داخلها فلسفة كاملة. فالحياة في جوهرها مبنية على التضحيات. لكن التضحية في سبيل كلمة حق تأخذ طابعاً خاصاً، لأنها ليست تضحية شخصية فقط، بل هي تضحية من أجل الآخرين أيضاً. فالذي ينطق بالحق يفتح الطريق لغيره كي يجرؤ. هو كمن يقدّم نفسه قرباناً ليؤسس تقليداً جديداً في الشجاعة.
في هذا السياق يمكننا أن نتأمل صورة الكاتب أو الصحفي أو المثقف وهو يجلس أمام ورقته أو شاشته، يعرف أن ما سيكتبه قد يُغضب سلطة، أو صديقاً، أو مجتمعاً بأسره، ولكنه يكتبه مع ذلك. هنا يصبح الفعل الكتابي فعلاً وجودياً، مواجهة بين "الخوف" و"الواجب". وحين ينتصر الواجب، يكون النص قد تجاوز حدود الحروف، وأصبح شهادة على زمنٍ بأكمله.
الذين يمارسون النقد الحقيقي يُطلب منهم أن يتخلّوا عن الغضب والندم. الغضب، لأنه يُفسد صفاء الرؤية، والندم، لأنه يقتل العزيمة. النقد ليس انفعالاً لحظياً، بل هو فعل عقلٍ وروح. الناقد الحق لا يكتب لأنه غاضب وحسب، بل لأنه مؤمن بأنّ ما يقوله ضرورة. وإذا ما تعرّض للرفض أو الأذى، فلا مجال للندم، لأن الكلمة التي قيلت خرجت من حدود الذات إلى فضاء الآخرين، ولم تعد ملك صاحبها.
الكاتب الأصلي للنص يقول: "وإذا لم يحتمل المنشغلون بالنقد متاعب هذه المهنة العسيرة، فليكسروا أقلامهم ويريحوا الناس ويريحوا أنفسهم أيضاً". وهذه العبارة تكثيف بالغ الدلالة. فالقلم ليس مجرد أداة للكتابة، بل رمز لمسؤولية. إنّ الإمساك بالقلم يعني قبول الدخول في ميدان المواجهة. ومن لم يكن قادراً على احتمال تلك المواجهة، فإنّ بقاءه في الميدان يُعدّ نوعاً من الخيانة، خيانة للقلم نفسه وللكلمة وللمجتمع.
كسر القلم هنا ليس مجازاً عن الاستقالة فقط، بل عن الانسحاب من ساحة الصراع الحضاري. وكأنّ الكاتب يريد أن يقول إنّ النقد ليس وظيفة من وظائف الحياة الفكرية، بل هو شرط من شروط حيوية المجتمع. فمن لا يستطيع أن يحمله بجدية، فالأجدر أن يترك الساحة لغيره، لأن الكلمة التي لا تُقال بصدق تتحوّل إلى خيانة مزدوجة: خيانة للحقيقة، وخيانة للناس الذين ينتظرون من الكلمة أن تكشف لهم الطريق.
في التاريخ المعماري للحضارات، يمكن أن نرى صورة النقد أيضاً. فالمباني الكبرى التي تركها الفراعنة أو الرومان أو العباسيون لم تكن مجرد حجارة ضخمة، بل كانت إعلاناً عن رؤية للعالم. والنقاد، بدورهم، يشبهون المعماريين الذين يشيّدون أبنية فكرية في العقول. إذا كان المعمار يغيّر أفق المدينة، فإنّ النقد يغيّر أفق الوعي. وإذا كان الأول يحتاج إلى صبر ومشقة ومواد نادرة، فإنّ الثاني يحتاج إلى صدقٍ وإخلاص وقدرة على الرؤية خلف السطح.
النقد ليس علاقة بين الناقد ومع مجتمع كامل. المجتمع الذي يرفض النقد يعيش في حالة إنكار جماعي، ويعيد إنتاج أوهامه باستمرار، حتى يتحول إلى كيان هشّ ينهار عند أول أزمة. بينما المجتمع الذي يتقبّل النقد يملك قدرة على التجدد.
النفس البشرية تعكس ذلك أيضاً. فالفرد الذي يرفض النقد يظلّ أسير صورته المتخيّلة، غير قادر على النمو. أما الذي يتقبّل النقد، وإن كان مؤلماً، فإنه يفتح لنفسه أفقاً جديداً للنضج. من هنا، يصبح النقد فعلاً يساهم في البناء النفسي والاجتماعي معاً، بالرغم من قسوته.
الكلمة ليست مجرد أصوات تُنطق أو حروف تُكتب. إنها قدرٌ، يلاحق صاحبه أينما ذهب. الناقد الحق يعرف أنه قد لا ينال التقدير في حياته، بل ربما لا يُفهم حتى. لكن الكلمة التي يقولها قد تبقى، وقد تأتي أجيال لاحقة لتقرأها فتجد فيها ما يضيء ظلامها.
لهذا فإنّ الكلمة الحق لا تموت، حتى لو كُسرت الأقلام. قد يُسجن الكاتب، قد يُنفى، قد يُهمّش، لكن نصوصه تبقى شاهدة، مثل جدران معبد قديم صمد أمام الريح والزلازل. في النهاية، ليست العبرة بما ينال الناقد في حياته، بل بما تتركه كلماته من أثرٍ في مجرى الزمن.