
قناع سحريّ، يجعل من الموظف المسالم ستانلي، بطلاً خارقاً، بوجه أخضر، ينقذ مدينته من عصابة الأشرار. تلك كانت حبكة فيلم "القناع" (1994)، أشهر أفلام الممثل الأمريكي جيم كاري في التسعينيات.
في إحدى الليالي، يعثر ستانلي على القناع الخشبي مصادفة وسط حزمة أوساخٍ في النهر، وحين يرتديه، تتلبّسه طاقة غريبة، تحوّله إلى شخصية تشبه الأبطال الخارقين المرسومين في سلاسل الكومكس.
يكشف القناع رغبات ستانلي المكبوتة في مهنته المملة ويومياته الرتيبة. يستشير مختصاً في الأقنعة وعلم النفس، ليفهم ما حلّ به، فيستنتج أن القناع ربما يكون مسكوناً بروح لوكي، إله الشغب والخداع والجموح في الأساطير النوردية.
ميزة القناع ليست في قدرته على منح من يرتديه طاقات خارقة، ولكن في كونه يضخّم جوانب موجودة أساساً في شخصيته، ويعطيها بعداً سحرياً. فحين يرتديه ستانلي ينقلب من الموظف الودود اللطيف، إلى شخصية مشاكسة ومنطلقة؛ ولكن حين يضعه غريمه قائد العصابة، تنكشف ملامحه المؤذية.

من خلال حبكته الطريفة، يناقش الفيلم سؤال الأقنعة الشائع، بين ما نسميه وجوهنا الحقيقية ووجوهنا الأخرى. فحين يختفي ستانلي خلف القناع، ويستر وجهه الإنساني المعلوم، ينكشف على حقيقته، ويفجّر مكنوناته، ويتحرّر من عبء ذاته.
في المسرحية الغنائية الشهيرة "هالة والملك"، يتخيل الأخوين الرحباني مدينة اسمها سيلينا، يحتفل أهلها بعيد يسمونه عيد "الوجه الثاني"، هو أقرب إلى الاحتفالات التي نسميها اليوم بالهالوين، حيث يرتدي الناس أزياء ووجوهاً تنكرية، ليتقمّصوا مشاهير، أو شخصيات من مسلسلات، أو حيوانات، أو رسوم كرتونية.
في المسرحية، وبمناسبة العيد، يرتدي أهالي المدينة أقنعة، تخفي هوياتهم وأساميهم، ولكنها تميط اللثام عن جوانب مخفية من ذواتهم، ربما يخجلون من التعبير عنها علناً، أو تمنعهم مكانتهم الاجتماعية من التصالح معها. مثلاً، يرتدي مستشار الملك وجه حمار، وترتدي زوجة العرّاف زي راقصة، وترتدي شابة أجبرها أهلها على الزواج وجه عصفورة.
تقاليد الانفلات من خلال التنكّر، في المهرجانات والأعياد، هي في جذورها شعائر ذات بعد ديني، إن عدنا إلى الكرنفالات التي عرفتها أوروبا خلال القرون الوسطى، في فترة كانت قبضة الكنيسة ورجال الدين محكمة على كلّ جوانب الحياة.

في الأسابيع السابقة للصوم السنوي، كانت المدن تشهد احتفالات صاخبة، تتخللها مواكب تنكرية تجوب الشوارع، تتيح للناس بأن يضعوا جانباً شخصياتهم الحقيقية، وأسماءهم، وسمعة أسرهم، وطبقاتهم الاجتماعية، ومسؤولياتهم، وينفلتوا إلى الرقص والإسراف في الطعام والشراب واللهو.
وكانت الكرنفالات مناسبة أيضاً لقول ما لا يقال في الأيام العادية، مثل السخرية من السلطات، والانقلاب على كلّ القواعد والأعراف المفروضة، فيصير الممنوع مباحاً، ويصير القناع حصناً لمرتديه، يمنع عنه العار أو اللوم.
حتى يومنا هذا، تحتفل ثقافات كثيرة بمهرجانات تنكرية، من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، مثل مهرجان البندقية الشهير، الذي تحوّل إلى مصدر إلهام للمسرح والفنون خلال القرون الماضية.
كغيرهم، كان سكان البندقية يحتفلون بالمهرجان، كمناسبة تباح خلالها المتعة والإسراف والإغواء وتبادل المواقع الطبقية والأدوار الجندرية، ما جعله مناسبة للخلق الفني والابتكار أيضاً.
وصمّم حرفيو البندقية أقنعة ذات معانٍ واستخدامات محدّدة، من أشهرها مثلاً قناع البوتا الأبيض الذي يخفي الوجه كله، ويحاط بغشاء أسود، يسمح بإخفاء الهوية بالكامل، إلى جانب قناع "طبيب الطاعون"، وهو قناع بمنقار طويل، بدأ استخدامه في القرن السابع عشر بعد انتشار الوباء.
تلك الأقنعة باتت لاحقاً من الأزياء المعتمدة في مسرح الملهاة الإيطالي Commedia dell'arte، والذي يعتمد على فنون الإيماء، وعلى ظهور شخصيات مقنعة، بأدوار وخصال وسمات بارزة لا تتغيّر.
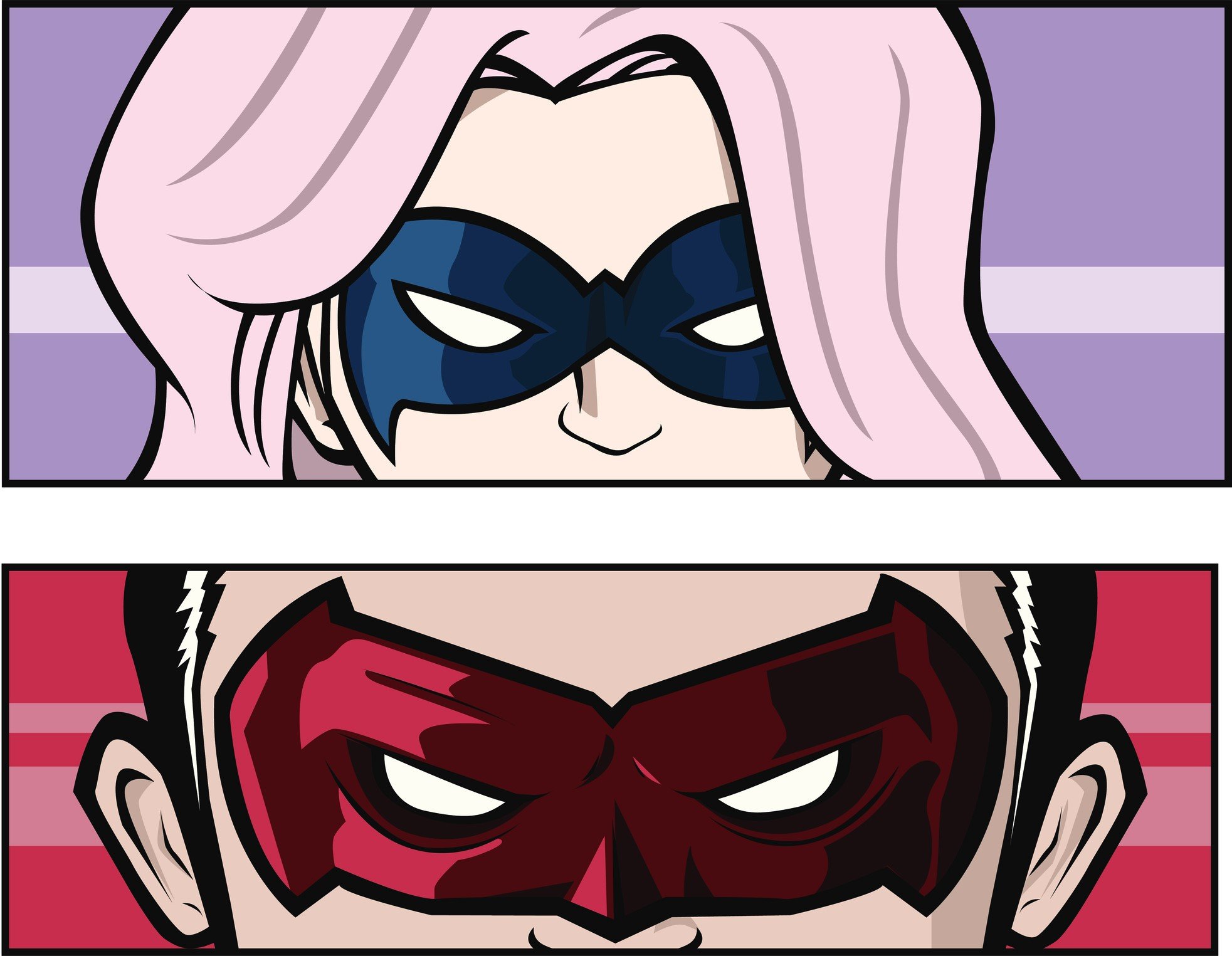
وبالعودة إلى قناع جيم كاري الأخضر، فإن تأثيره على من يرتديه، ينطلق من حبكة شائعة في معظم الأقاصيص الشعبية المعاصرة عن الأبطال الخارقين.
غالباً، يعيش البطل الخارق صراعاً بين هويته الحقيقية، بتناقضاتها، وصدماتها، وضعفها البشري، وبين دوره كمنقذ، لا يمكن أن يولد ويطلق العنان لمواهبه، إلا من خلف قناع أو زيّ.
في الأفلام والقصص المصوّرة، يتكرّر دوماً مشهد اكتمال البطل من خلف القناع، فلا يمكن لبشري إنقاذ الكوكب بشخصه العادي المعروف، بل عليه أن يضع حاجزاً بينه وبين خصاله البشرية العاجزة.
فحتى وإن لم يكن قناع باتمان سحرياً، ولا زيّ سبايدرمان مسكوناً بروح إله نوردي مشاكس، يمنح التنكّر البطل انعتاقاً من محدوديته، فيصير من أنصاف الآلهة، وتنفتح أمامه الآفاق، فيطير، ويقفز، ويحارب، ويحمل الأبنية، ينتشل الأطفال من بين الدمار، وينتقل عبر الزمن، ويقع في الحبّ.
لهذه الفكرة أيضاً جذور دينية، ففي الكثير من الديانات القديمة، خصوصاً عند سكان أمريكا الأصليين، وقبائل أفريقيا، كانت الأقنعة التنكرية صلة وصل بين عالم البشر، وعالم الأرواح.
شكلت تلك الأقنعة مصدر إلهام للفنانين التشكيليين مثل بيكاسو، وعدد من معاصريه، إذ رأوا فيها تعبيراً فنياً أصيلاً، ولا تزال المتاحف تعرضها ضمن مقتنياتها الثمينة. فتعابير الوجوه والعيون الجاحظة والأفواه المفتوحة، مثلت لحظة إبداع في التاريخ البشري، يحاول كثر تفكيكها والاستلهام منها.

عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي الشهير كلود ليفي ستروس خصص كتاباً لدراسة الأسلوب الفني لدى الشعوب الأصلية، من خلال الأقنعة التقليدية، بعنوان "طريق الأقنعة"، وفيه يقدّم بعض الإضاءات حول ارتباط تلك الأقنعة بما هو أبعد من التنكّر والاحتفال.
يخصص دارسو الأقنعة كتباً لفحصها بالتفصيل، ولكن باختصار، يكتب ليفي ستروس مثلاً عن قبائل سكان أمريكا الأصليين وشعائرهم، إذ كان هناك مكان خاصة في القبيلة لمن يمتلك القناع، ويلجأ إليه كل من يستعدّ لتنظيم احتفال زواج، أو مأتم، أو بوتلاش (تقليد احتفالي يعني تبادل المقتنيات والخيرات وإحراق فائض الإنتاج). فمن دون القناع، لا مجال لإتمام المراسم بالطريقة الصحيحة.
بعض الأقنعة كانت محصورة ضمن مقتنيات العائلات أو الطبقات رفيعة الشأن في القبائل، وتنتقل بالميراث أو بالزواج من الأم إلى أولادها، فترمز إلى الرخاء والسعادة.
وخلال الغزوات والحروب، كانت القبائل الأخرى تستحوذ على الأقنعة، ولكن ذلك لم يكن يشكل مصدر قلق بالنسبة لأصحابها الأصليين بحسب ليفي ستروس، لأن الغرباء لا يعرفون الشعائر التي "تفعّل" القناع.
وبحسب علماء الأنثروبولجيا، فإن قبائل السكان الأصليين كانت تعتقد أن الأقنعة نسخ نزلت من السماء، وجوه الأجداد والأسلاف، وكانت تستخدم في الصيد والعلاجات السحرية وشعائر قبول الشباب ضمن راشدي القبيلة.
كلّ ذلك كان يحتاج إلى مباركة الأرواح والأجداد والأسلاف، فالقناع هو أشبه ببوابة العبور والمفتاح السحري، بين حياة البشر، وعالم الأرواح.
بعض الأقنعة الشائعة كانت تمثل طواطم حيوانية (الطوطم هو رمز القبيلة المقدس وغالباً ما يكون حيواناً)، وبعضها الآخر، طاقات الطبيعة، أو أرواح الغابة المؤنثة المتوحّشة العملاقة.
وكانت الاعتقادات الدينية السائدة تنسب مصادر الأقنعة إلى السماوات العالية، أو أعماق المياه، أو أعالي الجبال، بمعنى أنها دوماً تمثيل لعالم آخر، يختلف بزمانه ومكانه عن حاضر البشر.

الأمر ذاته ينسحب على تقاليد عدد من القبائل الأفريقية التي لا يزال بعضها يستخدم الأقنعة كجزء من ميراثه وثقافته إلى اليوم. فالقناع كان غرضاً مقدساً محملاً برمزيات روحانية، إذ كان طريقة للتواصل مع أرواح الأسلاف، والسيطرة على قوى الخير والشر.
فحين يرتدي شخص ما القناع خلال إحدى الشعائر، لا يعود بشرياً، بل ينتقل إلى حالة عليا، وكأن أرواح الأجداد أو طاقات الطبيعة الكامنة في القناع، تتلبّس جسده. وكأن من يرتدي القناع يتخلّى عن ذاته لبعض الوقت، ويمنح جسده لطاقات الطبيعة، أو آلهة الخصوبة والطقس، لتسكنه.
وحين يرتدي قناعاً يمثل أحد الحيوانات، فإنه يأخذ خصال ذلك الحيوان وقواه الروحية، مثل القوة أو الحكمة.
عند المصريين القدماء، كان كهنة أنوبيس يخفون وجوههم خلف قناع خشبي يمثل شكل الإله صاحب رأس الذئب، خلال المراسم الجنائزية.
فالإله أنوبيس بحسب اعتقادات المصريين، كان حارس المدافن والقبور، والمسؤول عن عبور الأرواح بين عالم الأحياء وعالم الأموات. وعندما يضع الكاهن قناعه، فإنه يأخذ قدرات الإله، ويفتح الباب للروح في رحلتها.

في الحضارات الشرق آسيوية، قد تكون الأقنعة وسيلة للعبور، ولكن بالاتجاه المعاكس، فبدل أن يرتدي الإنسان القناع كي تتلبّسه الروح، تستخدم الأرواح الأقنعة لكي يسهل عليها التحدّث إلى البشر.
ذلك ما نجده في تقاليد مسرح النوه الياباني العريق الذي يعدّ أقدم شكل مسرحي لا تزال عروضه متواصلة منذ القدم، وتتوارثه العائلات كحرفة من جيل إلى جيل، بأقنعته، وأزيائه، وديكوراته.
تمتاز أقنعة النوه بخصائص مميزة، فمن خلالها يحدد جنس الشخصية، وعمرها، أو طبيعتها كروح صالحة، أو شريرة، أو كروح تمثل أحد الحيوانات.
في كلّ مسرحيات النوه، يتوسط الخشبة جسر، هو طريق عبور الأرواح إلى عالم البشر، للتلاعب بيومياتهم ومصائرهم، أو إبلاغهم برسائل من العالم الآخر.
تحمل الأقنعة إرثاً بشرياً ثقافياً وروحانياً مهماً، يتجاوز رمزيتها الحالية كأداة للتنكّر بغرض التسلية في ليلة هالوين.



