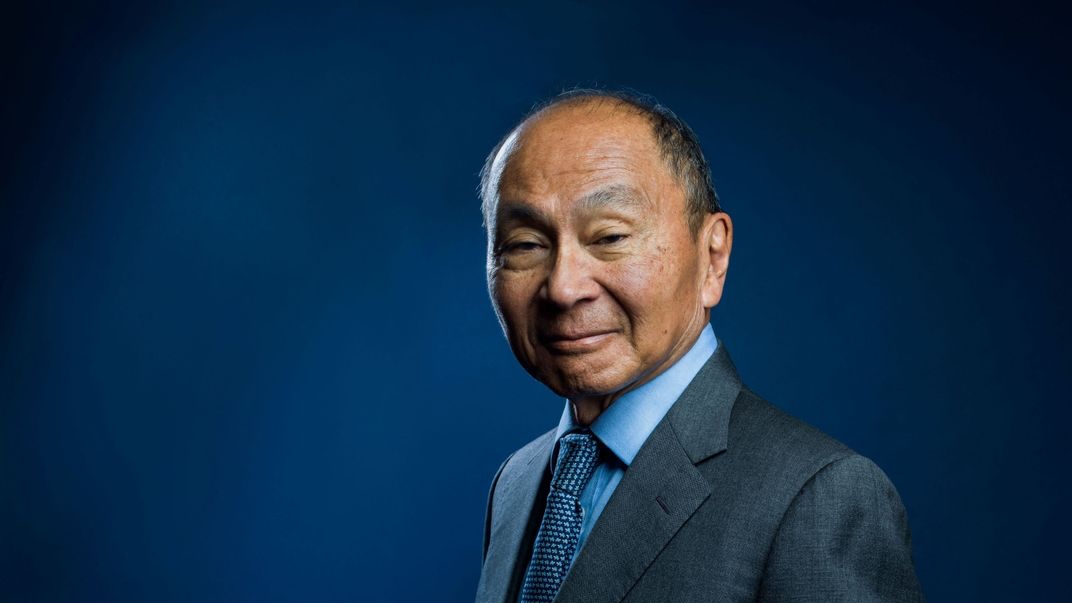منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ظهرت الليبرالية وكأنها النموذج النهائي لتنظيم السياسة والاقتصاد. هذه الفكرة عرضها فرانسيس فوكوياما أولاً في مقال بعنوان "نهاية التاريخ؟" (1989)، ثم توسع فيها لاحقًا في كتابه "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" (1992). غير أن العقود الثلاثة اللاحقة كشفت أزمة عميقة؛ إذ أصبحت الليبرالية محاصرة بين رأسمالية نيوليبرالية أفرزت تفاوتات هائلة في الثروة، ويسار هويّاتي انصرف إلى قضايا العرق واللون والجندر على حساب العدالة الاجتماعية الشاملة. هذه الضغوط المزدوجة أفقدت الليبرالية توازنها، فبدت عاجزة أمام الشعبويات المتصاعدة، مع تحولات تكنولوجية غذّت الاستقطاب وتغيرات جيوسياسية قلّصت من جاذبية النموذج الغربي. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل تمثل هذه التطورات نهاية الليبرالية، أم أنها فرصة لإعادة صياغتها كإطار عملي قادر على التكيف مع عالم سريع التحولات؟
في البعد الاقتصادي، ارتبطت الليبرالية بالرأسمالية باعتبارها وسيلة للحرية الفردية، لكنها انزلقت في ظل العولمة والنيوليبرالية إلى نمط اقتصادي تهيمن عليه الشركات العملاقة العابرة للقارات. وقد أفرز هذا النمط تفاوتًا صارخًا في توزيع الثروة، فيما كشفت الأزمات المالية، من انهيار 2008 إلى موجات التضخم بعد الجائحة وحرب أوكرانيا، عن هشاشة الاقتصادات حين يُختزل دور الدولة في ترك السوق يعمل وحده. هنا لم يعد الإنسان يُعامل بوصفه مواطنًا كامل الحقوق، بل يُختزل إلى مستهلك محاصر بمنطق الربح الأقصى.
في المقابل، برزت داخل الفضاء الليبرالي تيارات يسارية جديدة قدّمت نفسها كبديل، لكنها انشغلت بخطاب هويّاتي يركّز على قضايا العرق واللون والجندر على حساب العدالة الاجتماعية الشاملة. هذا التحول ضيّق النقاش العام، وأنتج حالة استقطاب حاد، بل وأفضى في بعض مظاهره إلى ما يُعرف بثقافة الإلغاء، حيث يُقصى الرأي المخالف بدل مجادلته. وبدل أن يكون خطابًا يوسّع أفق التعددية، أصبح يميل إلى إشاعة الكراهية وإغلاق المجال العام أمام التنوع الفكري.
ويزداد المأزق تعقيدًا حين تميل الليبرالية نفسها إلى تقديم وصفات جاهزة تُفرض على مجتمعات مختلفة وكأنها حلول شاملة. ما يصلح في سياق سياسي واجتماعي معين قد يكون عبئًا في سياق آخر، وحين تفشل الليبرالية في قراءة الواقع الملموس للشعوب، تفقد قدرتها على الإقناع وتتحول إلى مشروع نظري أكثر منه ممارسة واقعية.
وتتفاقم الأزمة بعاملين آخرين قلّما يُذكران: الأول هو التكنولوجيا الرقمية التي غذّت الشعبويات عبر خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، فعمّقت الانقسامات وروّجت الأخبار الكاذبة بديلاً عن تحري الدقة والنقاش الموضوعي. والثاني هو التحولات الجيوسياسية التي قلّصت ثقة المجتمعات في النموذج الغربي مع صعود قوى بديلة، ما جعل الليبرالية تفقد جاذبيتها الرمزية.
هكذا يجد المواطن العادي نفسه أمام خيارين كلاهما مكلف: سوق مهيمن يبدد العدالة الاجتماعية، أو خطاب هويّاتي مغلق يصادر حرية التعبير. وفي هذا الفراغ تمددت الشعبويات، يمينًا ويسارًا، بخطاب تعبوي حاد يَعِدُ بما عجزت الليبرالية عن تحقيقه، مستفيدة من تراجع الثقة بالمؤسسات التقليدية.
ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار الليبرالية مشروعًا منتهيًا. ففي المجال الاقتصادي، أظهرت التجارب المقارنة، مثل التجربة الاسكندنافية، إمكان الجمع بين حرية السوق وسياسات الرعاية الاجتماعية في صيغة تحقق النمو وتحافظ على الحد الأدنى من العدالة. أما في السياسة والثقافة، فإن الليبرالية تستطيع أن تستعيد قوتها إذا عادت للتعقل والتبصر بالواقع، لتغدو منهجًا نقديًا قادرًا على تفكيك الأيديولوجيات والنزعات الأحادية والثنائية التي تغلق المجال العام.
ما تحتاجه الليبرالية اليوم هو أن تتحول من نظرية جدلية إلى ممارسة واقعية تُقاس بقدرتها على معالجة الأزمات الفعلية للمجتمعات. فإذا بقيت أسيرة الشعارات والمناكفات تفقد ما تبقى من ثقة الناس بها، أما إذا أعادت تعريف نفسها كممارسة واقعية، عندها فقط يمكن أن تستعيد معناها بوصفها مشروعًا إنسانيًا قادرًا على التكيف مع عالم سريع التغيرات.