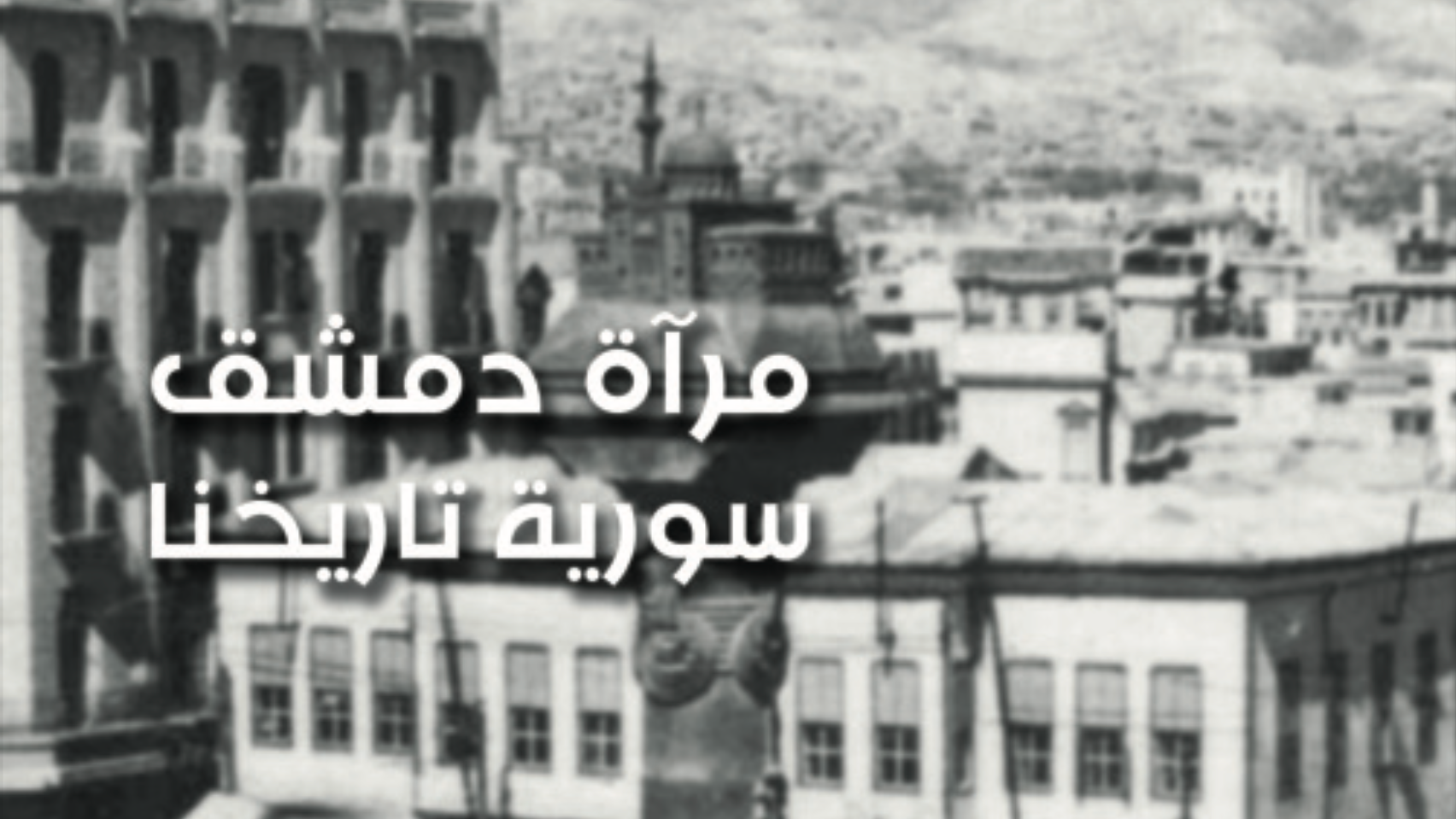يأتي كتاب "مرآة دمشق: سوريا تاريخنا" للمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو (ترجمة أ. ديمة الشكر - دار المتوسط 2023)، بعد عامين من إصداره عن دار "آكت سود" الفرنسية (2021)، في لحظة فارقة تعاد فيها صياغة السرديات السورية، وتتساقط فيها الأقنعة، وتُعاد كتابة الذاكرة بأقلام من خارج المكان، لكنها تدّعي الموضوعية واحتراف التأريخ. في هذا الكتاب، الذي يفترض أنه يقدم قراءة ثقافية - سياسية لتاريخ سوريا من خلال مرآة دمشق، تختزل العاصمة في صورة الوطن، وتُقصى المكونات غير المنتمية للمركز، أو تُعرض بصورة باهتة، مضلّلة، أو اتهامية.
أراد المؤرخ فيليو أن يستعيد سردية البلاد من خلال ما يسميه "النبض الدمشقي"، لكنه وهو يدوّن هذا التاريخ، أعاد إنتاج خريطة السلطة "البائدة" في زمن ديمومتها. زمن الكتابة والنشر، بما تحمله من تغييب للكرد، وغموض بشأن الدروز، وبترٍ في تمثيل الإيزيديين، ونظرة استعلائية للعلويين، وصورة مترددة للسنة. وبالرغم من رصانة اللغة، وسلاسة الترجمة، فإنَّ ما يُسكَت عنه، أو يُقال همسًا، كان أكثر بلاغة مما كُتب صراحة.
لقد تجنى الكاتب على الكرد فيما يتعلق بمذابح الأرمن، فقد جاء في الصفحة 126 من النسخة العربية، إنَّ "جزءًا من المذبحة لم يرتكبه العسكريون أو الميليشيات، بل لصوص أكراد". هكذا، ومنذ البداية، يظهر الكردي في خطاب الكاتب لا كضحية، بل كجلاد، لا كشريك مأساة، بل كمتواطئ، دون التوقف عند أي تحليل تاريخي أو سياق سياسي يُنقذ هذه الجملة من طابعها التعميمي الخطير، لا سيما في ظل توافر الكثير من المصادر التي ترى الكرد من أكثر حماة الأرمن خاصة والمسيحيين عامة، ناهيك عن أن ما تم إنما كان في ظل دولة ليست كردية. كما أنَّ المؤلف في الصفحة 211، عند الحديث عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لا يتناولها كمحاولة لتجاوز التهميش التاريخي بحق الكرد، بل كحالة انفصالية، فيقول: "في عام 2013، في المناطق التي شكّلها الانفصاليون الأكراد في روج آفا..."، دون أن يتطرق إلى مظلومية عمرها عقود، أو إلى إصرار هذه التجربة على التعددية والمواطنة، في مقابل خطاب قومي أحادي صاغ كل المراحل التي سبقتها. أما صلاح الدين الأيوبي، القائد الكردي الأشهر، والذي يرد ذكره كثيرًا، فيتم ربط كرديته برمزيته للقومية العربية - وهو غير مقبول من مؤرخ مثله - في إطار تشتيت وتضبيب للصورة الفعلية لشخصية هذا القائد.
ويمضي الكاتب في الإشارة إلى جذور آل جنبلاط، من خلال الحديث عن "علي جنبلاد"، حاكم حلب الكردي العثماني الذي انتقل إلى الشوف في مطلع القرن السابع عشر، حيث "عرّب اسمه إلى جنبلاط" و"اندمج في الزعامة الدرزية". لكن هذا التحول الذي يرويه لا يُقرأ بوصفه سردية تحوّل هوية، ولا يُستثمر لفهم تشكّل الوعي السياسي الدرزي، بل يُستعرض كخبر، لا أكثر. ومن ثم، فإنَّ الدروز يظهرون في الكتاب كمحض حالة اختلاف لغوي أكثر منهم كمكون فاعل أو ككيان له امتداد ورؤية، وهو ما يحوّلهم إلى مجرد شذرة تاريخية لا تتصل بجذرها المعاصر.
أما الإيزيديون، الذين لا يُذكرون في سياق المذابح والنزوح، فلا يُقدَّمون حتى كضحايا عابرين، ومن دون أن يُقال عنهم إنهم كرد أولًا، وإن الإيزيدية ليست سوى أحد الأوجه الروحية لتنوع كردي غني واقعي لا يمكن تجاوزه، وهم أبناء مكانهم تاريخًا وجغرافيا. فهم أبناء ديانة ضمن قومية هي الكردية، ومجتمع بلا سياق، وهامش بلا انتماء، وكأن المؤلف يُنكر على الجماعة المركبة وجودها الواقعي والتاريخي، فيسلبها حضورها في مؤلفه، ويركنها في ظلال التغييب من دون أن يُقرّ لها بحقها في سردية خاصة، وحقها في أن تُرى كما هي: جماعة عانت على أساس مزدوج - عرقي وديني - ولا تزال.
كما إن العلويين أيضًا لا يحضرون في الكتاب إلا من خلف زجاج السلطة. لا يحضر تاريخ قهرهم، ولا إسهاماتهم الثقافية، ولا محاولات بعض رموزهم لفصل الطائفة عن النظام. إذ يُختصر العلويون في كونهم بنية من بنى النظام، وكأنهم غير موجودين خارجه. لا تحليل للداخل العلوي، ولا قراءة للصراع الداخلي، ولا استدعاء للأدب الذي كتبه أبناؤهم من موقع المنفى أو المعارضة أو حتى كنتاج من موقع القلق وعدم الاستقرار، ضمن حالة التحديات التي باتت تترجم الآن. وكأن العلوي ليس إلا امتدادًا لمؤسسة أمنية، لا مكوّنًا له روايته، ومكانته، ومعاناته الخاصة.
وإذا كان الكاتب يلمّح أحيانًا إلى حضور "الأكثرية السنية"، فإنَّ هذا الحضور لا يُترجم إلى عمق فكري أو تحليلي. فهم بين خطابين: الأول إسلاموي، والثاني سلطوي، دون أن يمنحهم الكتاب فرصة الظهور كمكوّن وطني له خياراته وتياراته وتحولاتـه. إذ يُكتفى بهم كخلفية، كمجموعة صامتة تحيط بالمشهد ولا تصنعه.
أمَّا الترجمة التي أنجزتها ديمة الشكر، فقد جاءت رشيقة، أنيقة، سلسة من حيث اللغة. إلا أن الهوامش التي ترد في المتن هي هوامش المؤلف نفسه من الطبعة الفرنسية - كما يبدو - وتقتصر على الإحالات المرجعية أو التوضيحات التاريخية. أما المترجمة، فلم تضف شروحًا أو تعليقات من جانبها، وهو أمر ينسجم مع طبيعة هذا النوع من الإصدارات، حيث يُقدَّم النص كما هو من دون تدخل نقدي.
هكذا يظهر أن "مرآة دمشق"، بالرغم من ما تحمله من نوايا ثقافية، تبقى انعكاسًا مشوّهًا، لا لحقيقة سوريا، بل لرؤية انتقائية تنتقي من التاريخ ما يوافق هواها. سوريا فيها هي المركز، وكل ما عداه ظلّ. الكرد في هذا الكتاب لصوص أو انفصاليون، والدروز مجرد اختصار أو انتقال لغوي من كردية إلى زعامة جبلية، والإيزيديون لا ذكر لهم البتة، والعلويون كتلة سلطوية، والسنة صدى بلا صوت.
وبذلك، تتحوّل "مرآة دمشق" من محاولة للإنصاف إلى مرآة مشروخة، لا تعكس المكونات، بل تُقصيها، ولا تُنصت إلى الهامش، بل تصوّره كما تشاء، لا كما هو. وهنا، يكون النقد واجبًا لا ترفًا، ويكون الصوت الكردي، كما سائر الأصوات المستبعدة، أمام تحدٍ أخلاقي: أن يكتب نفسه بنفسه، لا أن ينتظر أن يراه الآخر في مرآة مكسورة.