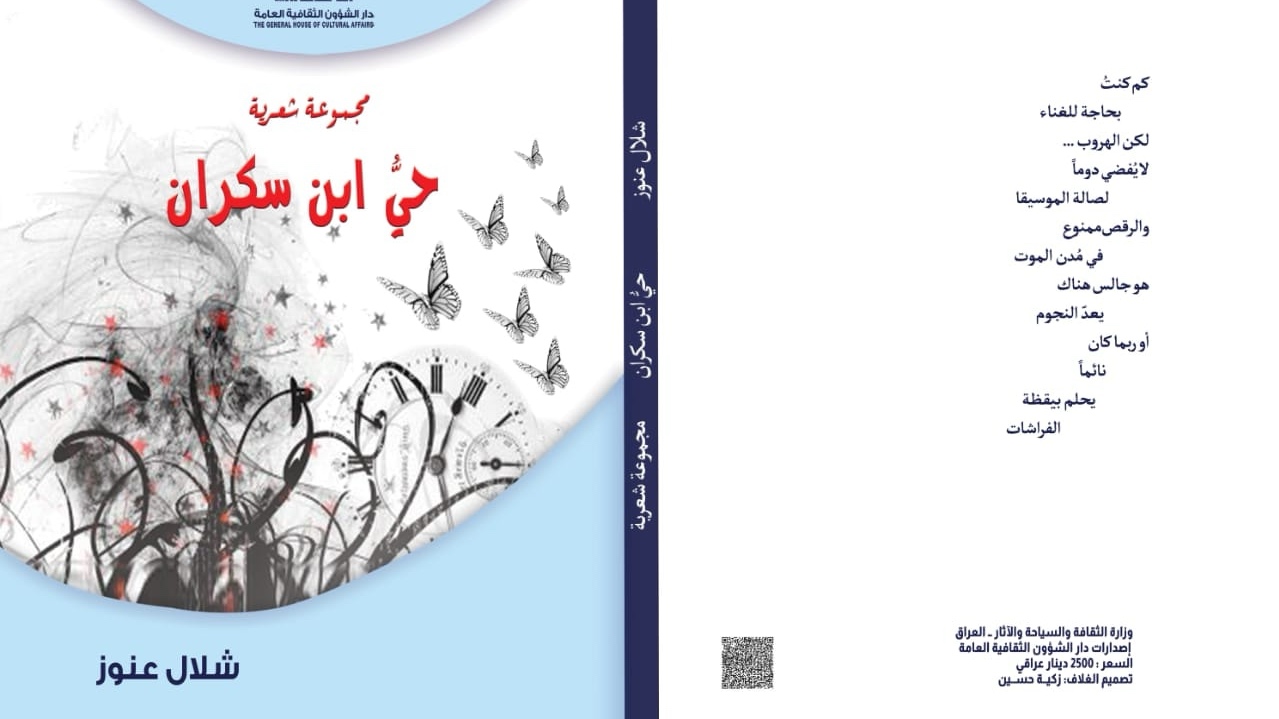يبدو العنوان "حيّ ابن سكران" هو الشرارة الأولى التي تفتح باب القراءة. فمن الواضح أنّ الشاعر يستعير بناء العنوان الفلسفي "حيّ بن يقظان"، لكنه يقلب دلالته رأسًا على عقب. فـ"يقظان" في نصّ ابن طفيل رمز للوعي والمعرفة والاكتشاف الذاتي في عزلة جزيرةٍ موحشة، أما "سكران" عند شلال عنوز فهو الوعي المكسور، الوعي المثمل بالخيبة والخذلان. بهذا التحوّل من اليقظة إلى السكر، ينتقل النصّ من المجال الفلسفي إلى المجال الوجودي-النفسي، ومن أفق المعرفة إلى أفق الألم. العنوان إذًا ليس مجرد تسمية، بل هو بنية لسانية تولّد المعنى، إذ يؤسس منذ البداية تناصًّا معاكسًا يفرّغ الأصل من دلالته ليعيد إنتاجه داخل سياقٍ جديد؛سياق الإنسان العربي المعاصر الذي لم يعد "يقظانًا" بل صار "سكرانًا" من فرط المآسي.
البنية اللغوية؛ اللسان بوصفه مرآة الوجع
يعتمد الشاعر في قصيدته على الاقتصاد اللغوي والقطع التركيبي، وهي سمة لسانية تخلق إيقاع التشنج النفسي. نلاحظ من أول الأسطر؛ "في مساءٍ / موغلٍ / بنوباتِ / الحزن / يَسْتَشيطُ أَلَماً". تقطيع الجملة إلى وحدات معزولة يوحي بتقطّع النفس نفسها، فكل مفردة تنفصل عن الأخرى كما تنفصل نبضات القلب عن انتظامها. من منظور لساني بنيوي، يمكن القول إنّ الشاعر يشتغل على المستوى التركيبي لتوليد دلالة الانكسار، فالفراغات بين الكلمات ليست بيضاء عبثًا، بل هي علامات صمت تشارك في إنتاج المعنى. أما على المستوى المعجمي، فيهيمن حقلٌ دلالي مرتبط بالألم والموت والجفاف؛ الحزن – المأساة – العذابات – الخيبات – الفقد – الأرق – الهاوية – اليباس – الوجع – الوحدة – الطعنات. هذا التكرار ليس عَرَضيًا، بل يشكّل ما يسميه علماء اللسانيات بـالانسجام المعجمي الذي يُبنى عبر تكرار مفردات حقلٍ واحد لإحكام الوحدة الشعورية للنص.
من الدال إلى المدلول؛ التحوّل اللساني للرمز
في المنهج اللساني، يُفهم الرمز بوصفه علاقة بين الدال (اللفظ) والمدلول (الفكرة). وعند شلال عنوز، تتولّد الرموز عبر الانزياح الدلالي لا عبر الزخرفة. فعندما يقول؛ “يُسائل طواحين الأرق"، فإنه يحوّل الأرق من حالةٍ نفسية إلى كائنٍ فاعلٍ يُسائل. إنّ الأرق هنا ليس شعورًا عابرًا، بل قوة ميتافيزيقية تسكن الذات وتحاورها. وبالمنهج اللساني التداولي، يمكن قراءة هذه الصورة بوصفها فعلَ كلامٍ من نوع "التساؤل الاستعاري"، حيث لا يريد الشاعر معرفةً، بل يريد احتجاجًا. إنّ السؤال هنا ليس استفهامًا، بل صرخة وجودية. التحوّل الأبرز في مستوى الدال هو توظيف الشاعر للأفعال في صيغة المضارع؛ (يستشيط، يقامر، يتلوّى، يناجي، ينتظر، يمسح، يسائل، يكتب). هذه الصيغة اللغوية تخلق زمنًا دائريًا، وكأنّ الحدث لا ينتهي، فالذات تظلّ في حالة احتراق مستمر. بذلك تتحوّل القصيدة إلى بنية دلالية مغلقة على التكرار، تعكس حالة الشاعر أو "بطله" الذي يعيش في حلقة وجعٍ لا تنكسر.
بين الحكاية والأسطورة؛ إعادة كتابة حيّ بن يقظان
الحكاية الأصلية "حيّ بن يقظان" تحكي عن إنسان نشأ في جزيرة معزولة، فاكتشف الحقيقة بالعقل والتأمل دون معلم. أما في قصيدة شلال عنوز، فإنّ حيّ ابن سكران هو إنسان معاصر، ليس في جزيرة معزولة، بل في عالمٍ مدمَّر، ولا يكتشف الحقيقة بالعقل، بل بالوجع. يقول الشاعر؛" آه يا (حيّ)... أيها المتأمل في قعر الوحشة / المنبوذ في فنجان الوحدة / المثخن بطعنات الأقارب والأباعد." هنا تتحول العزلة من فضاء للتأمل كما في نص ابن طفيل إلى قدرٍ منبوذ. فبدل أن يقود التأمل إلى المعرفة، يقود إلى السكر بالخذلان. هذه المفارقة التناصية تضع القصيدة في مواجهة الفلسفة القديمة، لتعلن ولادة إنسان ما بعد يقظان، الذي لم تعد المعرفة خَلاصَه، بل عذابه. من منظور لساني-سيميائي، هذا التناص ليس مجرد إشارة ثقافية، بل هو تحويل دلالي للعلامة؛ حيث يتغير مدلول الاسم نفسه. فـ"حيّ" الذي كان رمز الحياة والمعرفة، يصبح في النصّ الجديد حيًّا محاصرًا بالموت والخذلان، و"سكران" لا يشير إلى الثمل الحسي، بل إلى فقدان الاتزان بين الذات والعالم.
الوظيفة التداولية؛ اللغة كفعل احتجاج
في ضوء المنهج اللساني التداولي، يمكن القول إن القصيدة تتحول من خطاب وصفي إلى فعل لغوي احتجاجي. فالشاعر لا يصف العالم، بل يواجهه. انظر إلى قوله؛ "ما لهذه الدروب باكية تشير إلى الهاوية / وشراهة اليباس تذبح رقص المواسم." هذه الجملة ليست وصفًا طبيعيًا، بل توجيه خطابٍ للعالم بلغة الإنكار، أي ما يُعرف في التداولية بفعل "الاستفهام الإنكاري". فالشاعر يسائل لا ليتلقى جوابًا، بل ليُدين. حتى انتظار "ساعي البريد" يتحول إلى فعلٍ كلامي ساخر؛"ينتظرُ... ساعي البريد / ربما يحمل رسالةً / لكن الكوّة مغلقة / والسعاة لم يأتوا بعد." القصيدة هنا تتحول إلى مشهد تداولي من نوع "الانتظار المؤجَّل"، حيث كل فعلٍ لغوي (الانتظار، النداء، السؤال) ينتهي إلى العدم. إنّ اللغة نفسها تفشل في تحقيق التواصل، لتصبح جزءًا من مأساة النص.
التحليل الصوتي والإيقاعي؛ موسيقى الانكسار
في المنهج اللساني الصوتي، يمكن ملاحظة أن إيقاع القصيدة يعتمد على تكرار الأصوات الحلقية والرخوة (الحاء، الخاء، العين، الغين)، ما يخلق صدى من الألم المكتوم. مثلاً في قوله؛"في قعر الوحشة / المنبوذ في فنجان الوحدة." الصوت الحلقي (ع، ح، خ) يهيمن ليعبّر عن انغلاق الداخل. هذا الاستخدام للصوت لا يخضع للوزن التقليدي، بل لموسيقى داخلية ناتجة عن التكرار والتنغيم. إنها موسيقى الحنجرة المبحوحة لا القافية المنسّقة. القصيدة إذًا تستبدل النظام العروضي بنظام التنغيم العاطفي، وهو ما يسميه اللسانيون "الإيقاع التداولي"؛ أي الإيقاع الناتج عن انفعال المتكلم لا عن القافية.
التنافر الدلالي؛ البلاغة الجديدة
في المنهج اللساني البلاغي، تبرز قيمة التنافر الدلالي، أي اجتماع مفردات متضادة في حقلٍ واحد لتوليد التوتر المعنوي. مثلًا؛"رقص المواسم" في مقابل "شراهة اليباس"، "الرسالة" في مقابل "الكوّة المغلقة"، "سفنه" في مقابل "موانيه العطشى." هذا التنافر يجعل القارئ يعيش انزياحًا إدراكيًا بين الأمل واليأس، الحركة والسكون، الحضور والغياب. إنه انزياح لساني يوازي الانزياح الوجودي في التجربة العراقية والعربية المعاصرة. في القسم الأخير من القصيدة، يتحول الخطاب من وصفٍ موضوعي إلى نداءٍ مباشر؛"آه يا (حيّ)... أيها المتأمل في قعر الوحشة..." هذا الانتقال من الغائب إلى المخاطب يشير إلى ما يسميه التداوليون تحوّل أدوار الخطاب؛ إذ يتحول الشاعر من راوٍ إلى مخاطِب، ومن شاهدٍ إلى منادٍ. النداء هنا ليس موجّهًا لشخصٍ واقعي، بل لرمزٍ أسطوري، وكأن الشاعر يخاطب نفسه وقد انقسمت إلى "يقظانٍ" قديم و"سكرانٍ" جديد. وبهذا، تكتمل الدائرة اللسانية للقصيدة؛ فهي تبدأ من غياب المرسل (الذات المنكفئة في الحزن) وتنتهي بنداءٍ إلى المرسل إليه (الذات الأخرى الغائبة)، في حركة لغوية دائرية تجسّد ضياع التواصل في زمن الخراب.
اللسان بوصفه أداة مقاومة
على الرغم من طغيان المفردات السوداء، إلا أن القصيدة لا تنتهي باليأس. اللغة نفسها تصبح وسيلة مقاومة. فمجرد أن يكتب الشاعر "يكتب مرسال الوجع لحيّ ابن سكران" يعني أن الكلمة لا تزال قادرة على تسجيل الألم، وهذا في ذاته فعل حياة. من منظور لسان التواصل، فعل الكتابة هنا هو الفعل الإنجازي الذي يخلق وجودًا جديدًا للذات. الشاعر لا يصف حيّ ابن سكران فحسب، بل يخلقه بالكلمة، كما خلق ابن طفيل بطله حيّ بن يقظان بالعقل. لكن هنا، الخلق يتمّ بالوجع لا بالمعرفة. قصيدة "حيّ ابن سكران" للشاعر شلال عنوز ليست نصاً بكائياً ولا مناجاةً ذاتية فحسب، بل هي إعادة تشكيل للوعي العربي المعاصر بلغةٍ شعريةٍ وَلُغويةٍ تعي ذاتها وهي تكتب. في هذه القصيدة، تتحول اللغة إلى كائنٍ حيٍّ يتألم ويحتجّ، وتغدو الكتابة وسيلةً لفهم الخراب الداخلي الذي أصاب الإنسان العربي في زمن التيه والخذلان. من خلال عنوانها، تُحاور القصيدة التراث وتفككه، إذ تستدعي "حيّ بن يقظان" بوصفه رمزاً للعقل الكاشف والحكمة النورانية، لكنها تُعيد إنتاجه على هيئة "حيّ ابن سكران"؛ كائنٍ مُنهكٍ بالعزلة، غارقٍ في عتمة الوعي، يبحث عن معنى لا يأتي ورسالةٍ لا تصل. يتقاطع العنوانان في البنية الرمزية لا في الهدف. فـ"حيّ بن يقظان" يمثّل أسطورة النقاء العقلي والبحث الفلسفي عن الحقيقة في جزيرةٍ معزولةٍ عن العالم، أما "حيّ ابن سكران" فهو ابن الواقع الموبوء، الخارج من جزيرته إلى صحراءٍ لغويةٍ مهشّمة، لا يملك إلا أن يصرخ في وجه العدم. بهذا التوازي، تنقض القصيدة الأسطورة القديمة عن "العقل المخلّص"، وتستبدلها بأسطورةٍ جديدةٍ عن "الوجع المخلّص"، لتؤكد أن المعرفة لا تتجلى في صفاء الذهن، بل في عذاب الكلمة وهي تحاول النجاة من صمت العالم.
المنهج اللساني في قراءة النص، يكشف كيف يُعيد الشاعر بناء اللغة لتصبح ذاتها موضوعاً للقصيدة. فالتكرار، والانقطاع الإيقاعي، والتوزيع المكاني للكلمات فوق الصفحة، كلّها علامات على أن النص لا يروى، بل يُرى، ولا يُقرأ بقدر ما يُسمع كصرخةٍ من وجدانٍ مأزوم. إنّ الجمل المقطّعة والوقفات الطويلة والتعبيرات المتكررة ليست صدفة، بل هي تمثيلٌ بصريّ وسمعيّ لتمزق الذات. فاللغة عند شلال عنوز ليست أداة للتعبير عن الحزن، بل هي الحزن ذاته، وقد اتخذ هيئة القصيدة. من هنا، يمكن القول إن "حيّ ابن سكران" هو الوجه المعاصر لـ “حيّ بن يقظان" المخلوع من عرشه العقلي. إنه إنسان اليوم، الذي فقد يقظته وسط صخب الخراب، واكتفى بأن يسكر لا بالنبيذ، بل بالخيبة والانتظار. ساعي البريد لا يأتي، والكوّة مغلقة، والريح تقتلع فسائل الأمل؛ كلّها رموز لسقوط التواصل بين الذات والعالم. فالخطاب الشعري يتحوّل إلى مرآةٍ للانقطاع الإنساني في زمنٍ صار فيه المعنى ترفاً، واللغة غريبة في بيتها. هكذا، يكتب شلال عنوز قصيدته لا ليحاكي ابن طفيل، بل ليعلن قطيعة معه. فحيث انتهت أسطورة الوعي إلى التنوير، تبدأ أسطورة الوجع في ظلمةٍ لا خلاص منها إلا بالكتابة. "حيّ ابن سكران" إذن هو الشاعر والإنسان معا، المصلوب على حافة المأساة، الذي يُراهن على اللغة كآخر معجزة باقية بعد أن خانت الدنيا معنى اليقظة، وتركته وحيداً يكتب كي لا يزول.