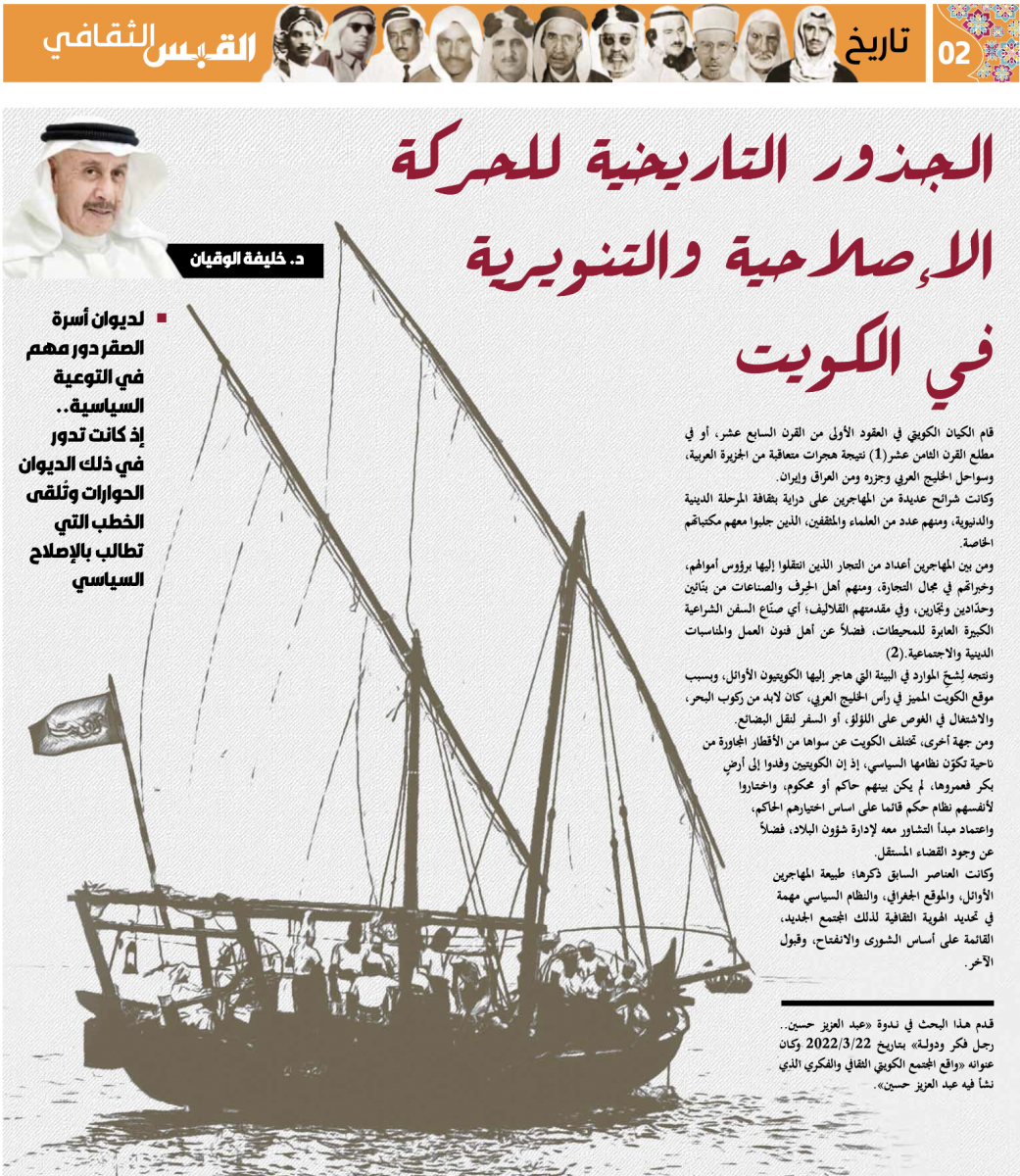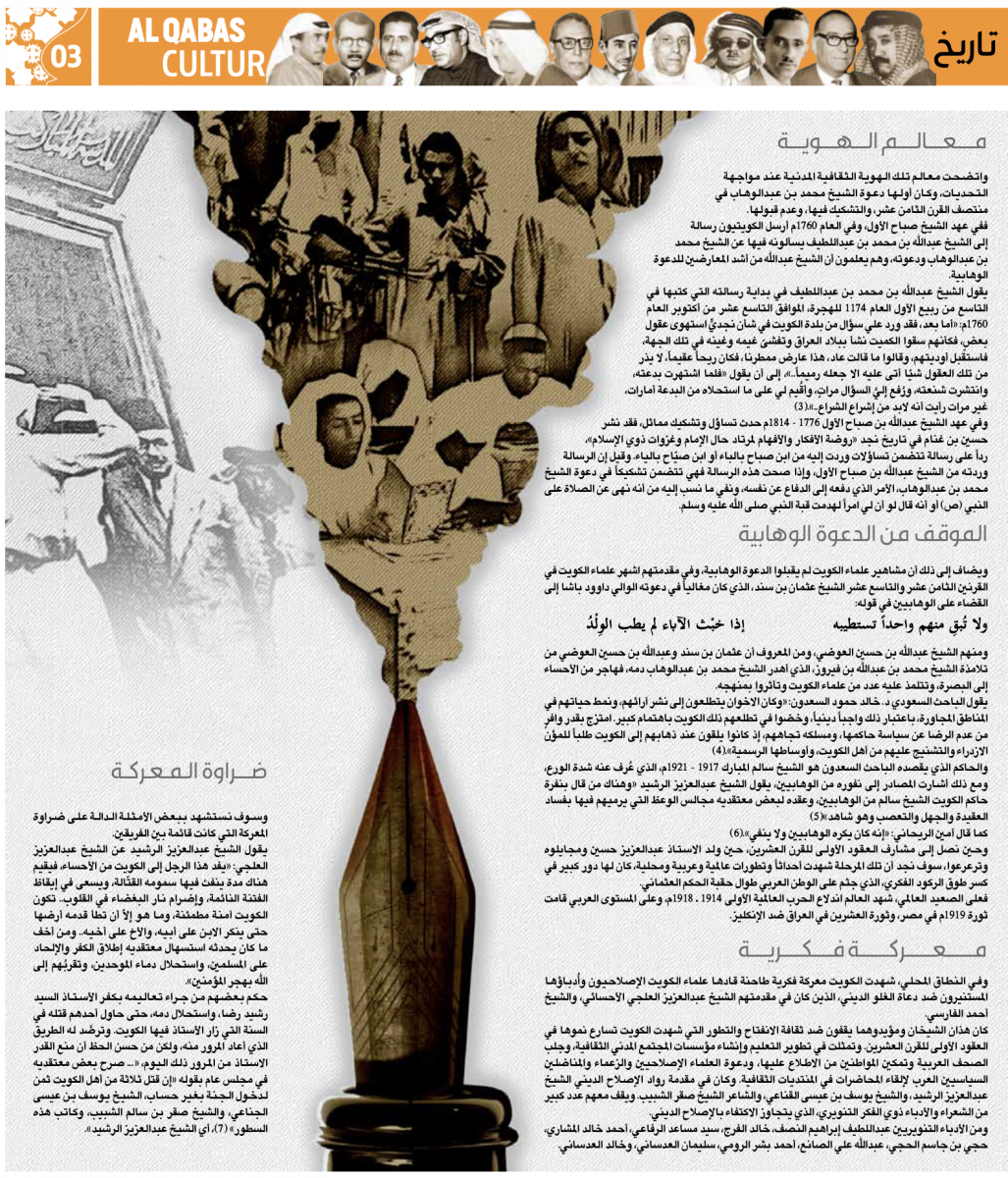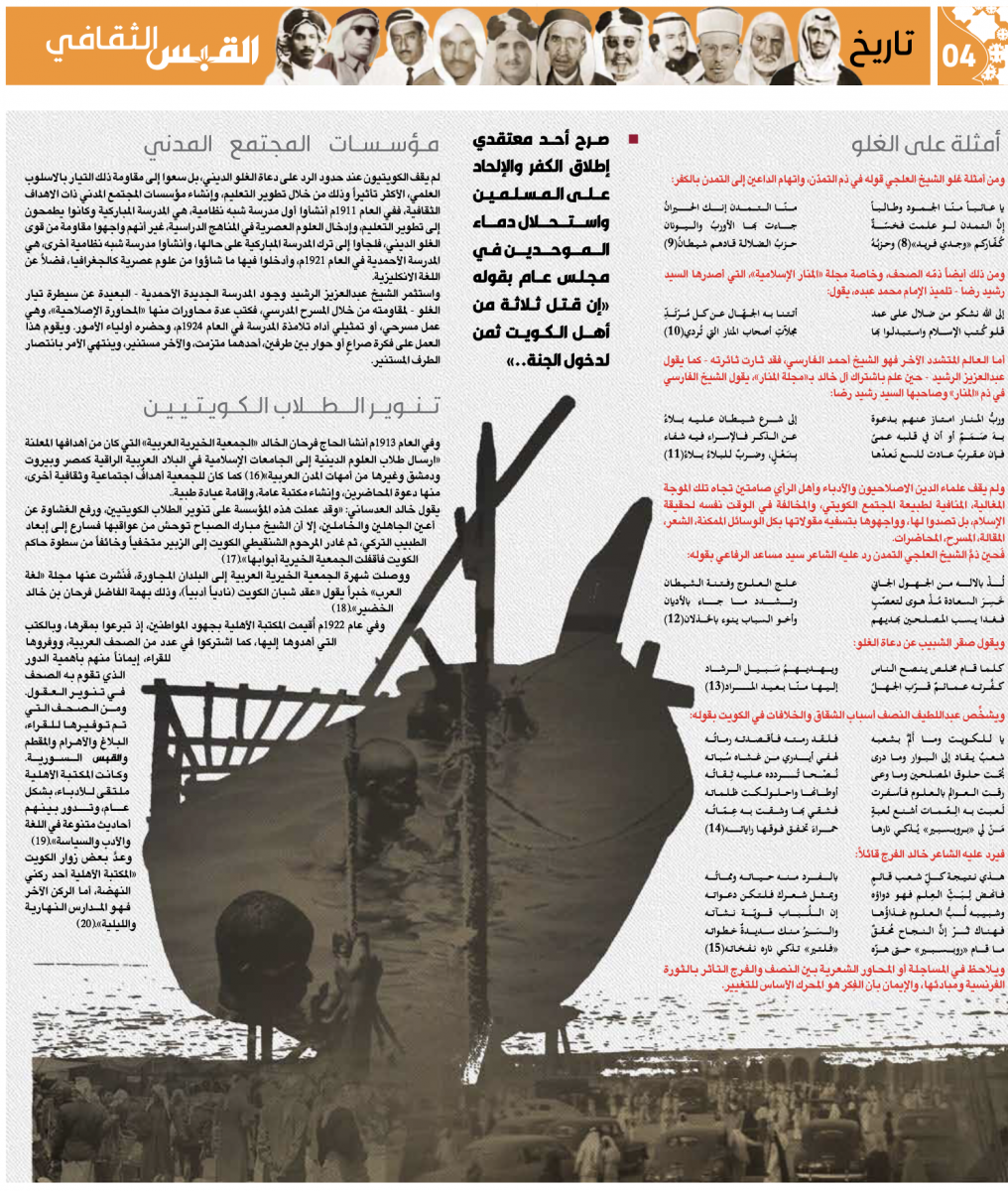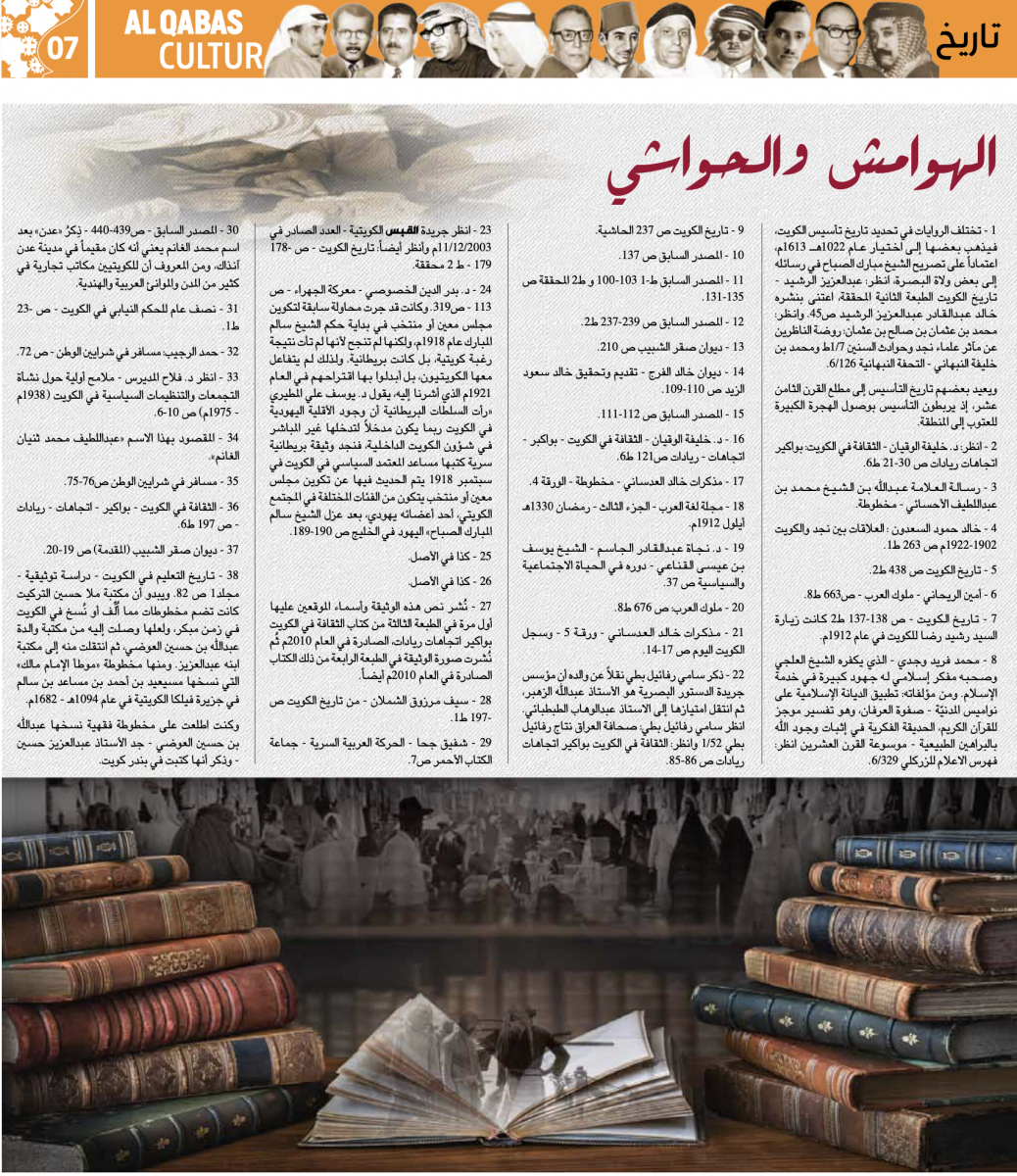ولد الأستاذ عبدالعزيز حسين في العام 1920م. وبغية الوصول إلى الحقبة التي ولد فيها، ثم تفتح وعيه، لابد من العودة إلى المراحل الأولى التي شهدت تشكّل الكيان الكويتي، ومن ثَمَّ اتضاح هويته الفكرية.
قام الكيان الكويتي في العقود الأولى من القرن السابع عشر، أو في مطلع القرن الثامن عشر(1) نتيجة هجرات متعاقبة من الجزيرة العربية، وسواحل الخليج العربي وجزره ومن العراق وإيران.
وكانت شرائح عديدة من المهاجرين على دراية بثقافة المرحلة الدينية والدنيوية، ومنهم عدد من العلماء والمثقفين، الذين جلبوا معهم مكتباتهم الخاصة.
ومن بين المهاجرين أعداد من التجار الذين انتقلوا إليها برؤوس أموالهم، وخبراتهم في مجال التجارة، ومنهم أهل الحِرف والصناعات من بنّائين وحدّادين ونجّارين، وفي مقدمتهم القلاليف؛ أي صنّاع السفن الشراعية الكبيرة العابرة للمحيطات، فضلاً عن أهل فنون العمل والمناسبات الدينية والاجتماعية.(2)
ونتجه لِشحِّ الموارد في البيئة التي هاجر إليها الكويتيون الأوائل، وبسبب موقع الكويت المميز في رأس الخليج العربي، كان لابد من ركوب البحر، والاشتغال في الغوص على اللؤلؤ، أو السفر لنقل البضائع.
ومن جهة أخرى تختلف الكويت عن سواها من الأقطار المجاورة من ناحية تكوّن نظامها السياسي، إذ أن الكويتيين وفدوا إلى أرضٍ بكر فعمروها، لم يكن بينهم حاكم أو محكوم، واختاروا لأنفسهم نظام حكم قائم على اساس اختيارهم الحاكم، واعتماد مبدأ التشاور معه لإدارة شؤون البلاد، فضلاً عن وجود القضاء المستقل.
وكان العناصر السابق ذكرها؛ طبيعة المهاجرين الأوائل، والموقع الجغرافي، والنظام السياسي مهمة في تحديد الهوية الثقافية لذلك المجتمع الجديد، القائمة على أساس الشورى والانفتاح، وقبول الآخر.
واتضحت معالم تلك الهوية الثقافية المدنية عند مواجهة التحديات، وكان أولها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في منتصف القرن الثامن عشر، والتشكيك فيها، وعدم قبولها.
ففي عهد الشيخ صباح الأول، وفي العام 1760م أرسل الكويتيون رسالة إلى الشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف يسألونه فيها عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته، وهم يعلمون أن الشيخ عبدالله من أشد المعارضين للدعوة الوهابية.
يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف في بداية رسالته التي كتبها في التاسع من ربيع الأول العام 1174 للهجرة، الموافق التاسع عشر من أكتوبر العام 1760م " أما بعد، فقد ورد علي سؤال من بلدة الكويت في شأن نجديٍّ استهوى عقول بعضٍ، فكأنهم سقوا الكميت نشأ ببلاد العراق وتفشىّ غيمه وغينه في تلك الجهة، فاستقبل أوديتهم، وقالوا ما قالت عاد، هذا عارض ممطرناً، فكان ريحاً عقيماً، لا يذر من تلك العقول شيّا أتى عليه الاّ جعله رميماً ..." إلى أن يقول " فلما اشتهرت بدعته، وانتشرت شنعته، ورُفع إليَّ السؤال مراتٍ، وأقُيم لي على ما استحلاه من البدعة أمارات، غير مرات رأيت أنه لابد من إشراع الشراع..."(3)
وفي عهد الشيخ عبدالله بن صباح الأول 1776 - 1814م حدث تساؤل وتشكيك مماثل، فقد نشر حسين بن غنام في تاريخ نجد (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وغزوات ذوي الإسلام، رداً على رسالة تتضمن تساؤلات وردت إليه من ابن صباح بالباء أو ابن صيّاح بالياء. وقيل أن الرسالة وردته من الشيخ عبدالله بن صباح الأول، وإذا صحت هذه الرسالة فهي تتضمن تشكيكاً في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الأمر الذي دفعه إلى الدفاع عن نفسه، ونفي ما نسب إليه من أنه نهى عن الصلاة على النبي (ص) أو أنه قال لو أن لي امراً لهدمت قبة النبي صلى الله عليه وسلم..
ويضاف إلى ذلك أن مشاهير علماء الكويت لم يقبلوا الدعوة الوهابية، وفي مقدمتهم اشهر علماء الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الشيخ عثمان بن سند، الذي كان مغالياً في دعوته الوالي دواود باشا إلى القضاء على الوهابيين في قوله:
ولا تُبقِ منهم واحداً تستطيبه إذا خبْث الآباء لم يطب الوِلْدُ
ومنهم الشيخ عبدالله بن حسين العوضي، ومن المعروف أن عثمان بن سند وعبدالله بن حسين العوضي من تلامذة الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز، الذي أهدر الشيخ محمد بن عبدالوهاب دمه، فهاجر من الأحساء إلى البصرة، وتتلمذ عليه عدد من علماء الكويت وتأثروا بمنهجه.
يقول الباحث السعودي د. خالد حمود السعدون "وكان الاخوان يتطلعون إلى نشر آرائهم، ونمط حياتهم في المناطق المجاورة ، باعتبار ذلك واجباً دينياً، وخصّوا في تطلعهم ذلك الكويت بإهتمام كبير. امتزج بقدر وافرٍ من عدم الرضا عن سياسة حاكمها، ومسلكه تجاههم، إذ كانوا يلقون عند ذهابهم إلى الكويت طلباً للمؤن الازدراء والتشنيج عليهم من أهل الكويت، وأوساطها الرسمية"(4)
والحاكم الذي يقصده الباحث السعدون هو الشيخ سالم المبارك 1917 - 1921م، الذي عُرف عنه شدة الورع، ومع ذلك أشارت المصادر إلى نفوره من الوهابيين، يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد "وهناك من قال بنفرة حاكم الكويت الشيخ سالم من الوهابيين، وعقده لبعض معتقدية مجالس الوعظ التي يرميهم فيها بفساد العقيدة والجهل والتعصب وهو شاهد"(5)
كما قال أمين الريحاني " أنه كان يكره الوهابيين ولا ينفي"(6)
وحين نصل إلى مشارف العقود الأولى للقرن العشرين، حين ولد الاستاذ عبدالعزيز حسين ومجايلوه، وترعرعوا فسوف نجد أن تلك المرحلة شهدت أحداثاً وتطوراتٍ عالميةً وعربيةً ومحلية كان لها دور كبير في كسر طوق الركود الفكري الذي جثم على الوطن العربي طوال حقبة الحكم العثماني.
فعلى الصعيد العالمي شهد العالم اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914-1918م، وعلى المستوى العربي قامت ثورة 1919م في مصر، وثورة العشرين في العراق ضد الانجليز.
وفي النطاق المحلي شهدت الكويت معركة فكرية طاحنة قادها علماء الكويت الاصلاحيون وأُدباؤها المستنيرون ضد دعاة الغلو الديني، الذين كان في مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز العلجي الأحسائي، والشيخ أحمد الفارسي.
كان هذان الشيخان ومؤيدوهما يقفون ضد ثقافة الانفتاح والتطور التي شهدت الكويتُ تسارع نموها في العقود الأولى للقرن العشرين. وتمثلت في تطوير التعليم وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني الثقافية، وجلب الصحف العربية وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها، ودعوة العلماء الاصلاحيين والزعماء والمناضلين السياسيين العرب لإلقاء المحاضرات في المنتديات الثقافية.
وكان في مقدمة رواد الإصلاح الديني الشيخ عبدالعزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى القناعي والشاعر الشيخ صقر الشبيب. ويقف معهم عدد كبير من الشعراء والأدباء ذوي الفكر التنويري، الذي يتجاوز الاكتفا بالإصلاح الديني.
ومن الأدباء التنويريين عبداللطيف إبراهيم النصف، خالد الفرج، سيد مساعد الرفاعي، أحمد خالد المشاري، حجي بن جاسم الحجي، عبدالله على الصانع، أحمد بشر الرومي، سليمان العدساني، خالد العدساني....
وسوف نستشهد ببعض الأمثلة الدالة على ضراوة المعركة التي كانت قائمة بين الفريقين.
يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد عن الشيخ عبدالعزيز العلجي: "يفد هذا الرجل إلى الكويت من الأحساء، فيقيم هناك مدة ينفث فيها سمومه القتّالة، ويسعى في إيقاط الفتنة النائمة، واضرام نار البغضاء في القلوب... تكون الكويت آمنة مطمئنة، وما هو إلاّ أن تطأ قدمه أرضها حتى ينكر الابن على أبيه، والأخ على أخيه .... ومن أخف ما كان يحدثه استسهال معتقديه إطلاق الكفر والإلحاد على المسلمين، واستحلالُ دماء الموحدين، وتقربُهم إلى الله بهجر المؤمنين.
حكم بعضهم من جراء تعاليمه بكفر الأستاذ السيد رشيد رضا، واستحلال دمه، حتى حاول أحدهم قتله في السنة التي زار الأستاذ فيها الكويت. وترصَّد له الطريق الذي أعاد المرور منه، ولكن من حسن الحظ أن منعه القدر الاستاذ المرور ذلك اليوم" ... صرح بعض معتقديه في مجلس عام بقوله (إن قتل ثلاثة من أهل الكويت ثمن لدخول الجنة بغير حساب الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، والشيخ صقر بن سالم الشبيب وكاتب هذه السطور"(7) ، أي الشيخ عبدالعزيز الرشيد.
ومن أمثلة غلو الشيخ العلجي قوله في ذم التمدن، واتهام الداعين للتمدن بالكفر:
يا عائباً منّا الجمود وطالباً
منّا التمدن إنك الحيرانُ
إِنَّ التمدن لــو علمت فخسّـــةٌ
جاءت بها الأوربُ واليونان
كُفّاركم "وجدى فريد"(8) وحزبُهُ
حزبُ الضلالة قادهم شيطانُ(9)
ومن ذلك أيضاً ذمة الصحف، وخاصة مجلة "المنار الإسلامية" التي أصدرها السيد رشيد رضا - تلميذ الإمام محمد عبده ؛ يقول :
إلى الله نشكو من ضلال على عمد
أتتنا به الجهّال عن كل مُرْتَدِّ
قلو كُتب الإسلام واستبدلوا بها
مجلاّتِ أصحاب المنار التي تُردي(10)
أما العالم المتشدد الآخر فهو الشيخ أحمد الفارسي، فقد ثارت ثائرته - كما يقول عبدالعزيز الرشيد - حين علم باشتراك آل خالد بـ "مجلة المنار" يقول الشيخ الفارسي في ذم المنار وصاحبها السيد رشيد رضا:
وربُّ المنار امتاز عنهم بدعوة
إلى شرع شيطان عليه بلاءُ
بهَ صَمَمٌ أو أن في قلبه عمىً
عن الذكر فالإسراء فيه شفاء
فإن عقربٌ عادت للسع نَعدْها
بِنَعْلٍ، وضربٌ للبلاءُ بلاءُ(11)
ولم يقف علماء الدين الاصلاحيون والأدباء وأهل الرأي صامتين تجاه تلك الموجه المغالية، المنافية لطبيعة المجتمع الكويتي، والمخالفة في الوقت نفسه لحقيقة الإسلام، بل تصدوا لها، وواجهوها بتسفيه مقولاتها بكل الوسائل الممكنة، الشعر، المقالة، المسرح، المحاضرات.
في حين ذمَّ الشيخ العلجي التمدن رد عليه الشاعر سيد مساعد الرفاعي بقوله:
لُذْ بالاله من الجهول الجاني
علج العلوج وفتنة الشيطان
خَسِرَ السعادة مُذْهوى لتعصّبٍ
وتشدد ما جاء بالأديان
فغدا يسب المصلحين بهديهم
وأخو السباب ينوء بالخذلان(12)
ويقول صقر الشبيب عن دعاة الغلو:
كلما قام مخلص ينصح الناس
ويهديهمُ سَبيل الرشاد
كفَّرته عمائمٌ قرّب الجهـ
لُ إليها منّا بعيد المراد(13)
ويشخِّص عبداللطيف النصف أسباب الشقاق والخلافات في الكويت بقوله:
يا للكويت وما أَلمَّ بشعبه
فلقد رمته فأقصدته رماتُه
شعبٌ يقاد إلى البوار وما درى
لهفي أيدري من غشاه سُباته
بُحّت حلوق المصلحين وما وعي
نُصْحا تُردده عليه ثِقاتُه
رقت العوالم بالعلوم فأسفرت
أوطانها واحلولكت ظلماته
لَعبت به الِعّمات أشنع لعبةٍ
فشقي بها وشقت به عِمّاتُه
مَنْ لي "بروبسبير" يُذكي نارها
حمراءَ تخفق فوقها راياته(14)
فيرد عليه الشاعر خالد الفرج قائلاً:
هذي نتيجة كلِّ شعب قائمٍ
بالفرد منه حياته ومماتُه
فانهض لِبَثِّ العِلم فهو دواؤه
وبمثل شعرك فلتكن دعواته
وشبيبه لُبُّ العلوم غذاؤُها
إن اللُباب قويّة نشآته
فهناك ثُرْ إنَّ النجاح مُحققٌ
والسَيرُ منك سديدةٌ خطواته
ما قام "روبسبير" حتى هزّه
"فلتير" تذكي ناره نفخاته(15)
ويلاحظ في المساجلة أو المحاور الشعرية بين النصف والفرج التأثر بالثورة الفرنسية ومبادئها، والإيمان بأن الفِكر هو المحرك الأساس للتغيير.
مؤسسات المجتمع المدني
لم يقف الكويتيون عند حدود الرد على دعاة الغلو الديني، بل سعوا إلى مقاومة ذلك التيار بالاسلوب العلمي، الأكثر تأثيراً وذلك من خلال تطوير التعليم، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهداف الثقافية، ففي العالم 1911م أنشأوا أول مدرسة شبه نظامية، هي المدرسة المباركية وكانوا يطمحون إلى تطوير التعليم، وإدخال العلوم العصرية في المناهج الدراسية، غير أنهم واجهوا مقاومة من قوى الغلو الديني، فلجأوا إلى ترك المدرسة المباركية على حالها، وأنشأوا مدرسة شبه نظامية أخرى، هي المدرسة الأحمدية في العام 1921م، وأدخلوا فيها ما شاؤوا من علوم عصرية كالجغرافيا، فضلاً عن اللغة الانجليزية.
واستثمر الشيخ عبدالعزيز الرشيد وجود المدرسة الجديدة الأحمدية - البعيدة عن سيطرة تيار الغلو - لمقاومته من خلال المسرح المدرسي، فكتب عدة محاورات منها " المحاوره الإصلاحية"، وهي عمل مسرحي، أو تمثيلي أداه تلامذه المدرسة في العام 1924م، وحضره أولياء الأمور. ويقوم هذا العمل على فكرة صراعٍ أو حوار بين طرفين، أحدهما متزمت، والآخر مستنير، وينتهي الأمر بانتصار الطرف المستنير.
وفي العام 1913م أنشأ الحاج فرحان الخالد "الجمعية الخيرية العربية" التي كان من أهدافها المعلنة "ارسال طلاب العلوم الدينية إلى الجامعات الإسلامية في البلاد العربية الراقية كمصر وبيروت ودمشق وغيرها من أمهات المدن العربية"(16) كما كان للجمعية أهدافٌ إجتماعية وثقافية أخرى، منها دعوة المحاضرين، وإنشاء مكتبة عامة، وإقامة عيادة طبية ...
يقول خالد العدساني "وقد عملت هذه المؤسسة على تنوير الطلاب الكويتيين، ورفع الغشاوة عن أعين الجاهلين والخاملين، إلا أن الشيخ مبارك الصباح توحش من عواقبها فسارع إلى إبعاد الطببيب التركي، ثم غادر المرحوم الشنقيطي الكويت إلى الزبير متخفياً وخائفاً من سطوة حاكم الكويت فأقفلت الجمعية الخيرية أبوابها.(17)
ووصلت شهرة الجمعية الخيرية العربية إلى البلدان المجاورة فَنَشرت عنها مجلة " لغة العرب" خبراً يقول " عقد شبان الكويت (نادي أدبي)، وذلك بهمة الفاضل فرحان بن خالد الخضير"(18).
وفي العام 1922م أُقيمت المكتبة الأهلية بجهود المواطنين، إذ تبرعو بمقرها وبالكتب التي أهدوها إليها، كما اشتركوا بعدد من الصحف العربية، ووفروها للقراء، إيماناً منهم بأهمية الدور الذي تقوم به الصحف في تنوير العقول. ومن الصحف التي تم توفيرها للقراء، البلاغ والأهرام والمقطم والقبس السورية. وكانت المكتبة الأهلية ملتقى للأدباء، بشكل عام، وتدور بينهم أحاديث متنوعة في اللغة والأدب والسياسة"(19).
وعدَّ بعض زوار الكويت " المكتبة الأهلية أحد ركني النهضة، أما الركن الآخر فهو المدارس النهارية والليلية"(20).
لم يكن إنشاء النوادي الأدبية مقبولاً من قِبَل السلطة السياسية غير أن المثقفين، والسياسيين، وأهل الرأي كانوا على درجة عالية من الوعي، الأمر الذي مكّنهم من تحقيق الأهداف بإبتكار البدائل؛ فحين تعذر عليهم الحصول على الموافقة لإنشاء النادي الأدبي أنشأوا الجمعية الخيرية العربية 1913م ثم المكتبة الأهلية 1922م، وحين حققت هاتان المؤسستان الأهليتان بعض أهدافهما، المتعلقة بتنمية الوعي، أصبح الانتقال إلى الخطوة التالية، أي افتتاح النوادي الأدبية أمراً واقعاً، وعلى هذا الأساس تم افتتاح النادي الأدبي في العام 1924م.
مارس النادي الأدبي نشاطه المهم، الذي كان صداه يتعدى الكويت يقول خالد العدساني - صاحب فكرة إنشاء النادي الأدبي " في سنة 1342هـ 1924م تمخضت هذه الموجات الفكرية والمعاهد الأدبية والعلمية عن حركة نشطة كان من نتاجها افتتاح النادي الأدبي .. وقد أحدث هذا النادي الكبير في السنين الأولى من تأسيسه حركة أدبية، ويقظة ذهنية لا بأس بها، بين صفوف الشباب ... وانتسب إلى عضويته ما يناهز المائة منهم وألقيت فيه محاضرات علمية وأدبية متنوعة كان لها دويُّها البعيد لافي الكويت وحدها، بل فيما جاورها من إمارات الساحل العربي أيضاً(21).
الصحافة
آمن الكويتيون منذ فترة مبكرة بأهمية الصحافة في التوعية، فاشتركوا في عدد من الصحف العربية ووفروها في دواوينهم للقراء، كما وفروها من بعدُ في المكتبات العامة.
واتصل الكويتيون بالصحف العربية، وخاصة المصرية والعراقية منذ مطلع القرن العشرين، ونشروا فيها كثيراً من المقالات والتقارير. فضلاً عن قيامهم بإصدار الصحف خارج بلادهم، حين تعذر عليهم إصدارها في الكويت.
فحين وقع الشيخ مبارك الصباح اتفاقية الحماية مع بريطانيا في العام 1899م نشر معارضو الاتفاقية، وأنصار الدولة العثمانية من الكويتيين مقالات في جريدة اللواء المصرية، التي كان يصدرها مصطفى كامل.
ويرى الأستاذ يعقوب الإبراهيم أن هناك تشابهاً في عالم الصحافة بين ما تم في مصر والقاهرة بالذات، حيث ساهم الصحافيون الشوام في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فنرى مثلاُ فيليب تقلا قد أسس الأهرام، وفارس نمر مؤسس المقطم، وجرجي وأميل زيدان مؤسسي دار الهلال وما حصل في البصرة، وفي الفترة نفسها تقريباً وبعدها، حيث أسس السيد عبدالوهاب الطبطبائي جريدة الدستور عام 1912م(22)، وأعقبها بـ " صدى الدستور" وأصدر السيد هاشم الرفاعي جريدة البصرة اليومية، في فبراير 1937م، كما ساهم جاسم حمد الصقر بتأسيس دار نشر وطباعة أصدرت جريدة الناس في فبراير 1947م.
كما كانت الاقلام الكويتية تساهم مساهمة صحفية فاعلة وغزيرة، منهم السيد عبدالوهاب الطبطبائي. والسيد هاشم الرفاعي، وعبدالعزيز الرشيد، وخالد سليمان العدساني، وعبدالله الجوعان، ومحمد السيد يوسف الرفاعي، وأحمد السيد عمر، وحمد موسى الفارس، إضافة إلى أقلام تكتب بأسماء مستعارة"(23).
ونتيجة لهذه الخبرة التي اكتسبها الكويتيون في المجال الصحافي خارج البلاد قرر الشيخ عبدالعزيز الرشيد المغامرة بإصدار مجلة كويتية، وتحقق له ما أراد في العام 1928م؛ إذا صدر مجلة ثرية المحتوى هي "مجلة الكويت".
كما أصدر مجلتيين أخريين حين استقر بضع سنوات في اندونيسيا والمجلتان هما : "الكويت والعراقي" 1930م. إذ تعاون مع السائح العراقي يونس بحري في إصدارها بعد توقف مجلة الكويت" عن الصدور. ويعني ذلك الاسم الكويت بمعنى مجلة الكويت، التي صدرت في العام 1928م والعراقي بمعنى شريكه في إصدارها السائح العراقي يونس بحري.
أما المجلة الأخرى التي أصدرها الرشيد في أندونيسيا فهي التوحيد 1933م.
تطور الفكر السياسي
لم يكتف الكويتيون بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن الثقافي والاجتماعي، بل سعوا إلى تطوير نظام الحكم، وترسيخ مبدأ الشورى ومن ثَمَّّ الديموقراطية من خلال العمل المؤسسي، ويتضح ذلك من خلال تجربتي مجلس الشورى 1921م ومجلس الأمة التشريعي 1938م.
ففي مطلع العام 1921م شرع بعض التجار في مناقشة "اقتراح إجبار الشيخ سالم المبارك على إقامة مجلس يتألف من حوالي ستة من الشخصيات البارزة، ومن بينهم الشيخ أحمد الجابر كمستشارين دائمين، لاعتقادهم أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سلام دائم، قدر الإمكان. وقد عرف من أصحاب هذه الفكرة حمد الصقر"(24).
وتوفي الشيخ سالم في 22 فبراير 1921م قبل تنفيذ هذا الاقتراح، فاجتمعت مجموعة من الوجهاء في ديوان الوجيه الحاج ناصر البدر، ودوّنوا وثيقة تتضمن مطالبهم الهادفة إلى تطوير نظام الحكم، وقرروا تسليمها إلى الأمير الجديد الشيخ أحمد الجابر الصباح حال عودته إلى الكويت، وقبل استلامه الحكم، وفيما يلي نص الوثيقة:
"نحن الواضعون أسماءنا بذيل هذه الورقة قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله وميثاقه على هذه البنود الآتية:
أولا:
1- إصلاح بيت الصباح كيلا يجرى بينهم خلاف في تعيين الحاكم.
2- ان المرشحين لهذا الأمر هم الشيخ أحمد الجابر والشيخ حمد المبارك والشيخ عبدالله السالم.
3- إن "ارتضى"(25) عائلة الصباح على تعيين واحد من الثلاثة فبها ونعمت، وإن فوّضوا الأمر للأهالي عيّناه، وان إرادت الحكومة تعيين واحد منهم رضينا به.
4- المعين لهذا الأمر يكون بصفة رئيس مجلس شورى.
5- يُنتخب من آل الصباح والأهالي "عدداً معلوماً"(26) لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والإنصاف.
حرر في 15 جمادي الآخر 1339هـ ويوافق 24 من فبراير 1921م.
ناصر يوسف البدر، حمد عبدالله الصقر، إبراهيم بن مضف، أحمد الحميضي، أحمد الفهد الخالد، عثمان الراشد، خالد المخلد، محمد شملان، محمد الزاحم عبدالرحمن محمد البحر، مبارك ساير، سلطان البراهيم الكليب، عبدالله الصميط، فهد العبداللطيف الفوزان، عبدالمحسن الصبيح، فلاح الخرافي، علي بن إبراهيم الكليب، يوسف بن عيسى، عبداللطيف الحمد، يوسف الرشيد، حمد الصميط، مسعود بن مشحن الرشيدي، عبيدان المحمد، محمد بن إبراهيم القلاف.(27)
ويرجع للاستاذ سيف مرزوق الشملان سبق الفضل في نشر وثيقة أخرى مماثلة في كتابة "من تاريخ الكويت، الصادر في العام 1959م، وثمة اختلاف طفيف بين الوثيقتين في البند الثالث.
ووقع على الوثيقة التي نشرها الأستاذ سيف الشملان ثمانية من وجهاء الحي الشرقي لمدينة الكويت، على حين وقع على الوثيقة التي نشرتها في كتاب الثقافة في الكويت في العام 2010م أربعة وعشرون وجيهاً، معظمهم من الحي القبلي لمدينة الكويت.
وفيما يلي أسماء الموقعين على الوثيقة التي نشرها الأستاذ سيف مرزوق الشملان: محمد شملان، مبارك بن محمد بورسلي، جاسم بن محمد بن أحمد، عبدالرحمن بن حسين العسعوسي، صالح بن أحمد النهام، عبدالله بن زايد، سالم بن علي بوقمّاز، ناصر بن إبراهيم.(28)
وتم تنفيذ مطلب تعيين مجلس للشورى في العام 1921م، غير أنه لم يعمر طويلاً، كما أنه لم يحقق طموحات النخبة السياسية، ولذلك امتد الطموح، وتطورت المطالب في العام 1938م لتصبح مطالبة بإنشاء مجلس تشريعي منتخب، وإصدار دستور للبلاد.
وقد تحقق ذلك الهدف، إذ تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة التشريعي في العام 1938م، كما تم إقرار القانون الأساسي الذي تنص مادته الأولى على أن "الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين".
العمل التنظيمي السياسي
أدرك الكويتيون منذ فترة مبكرة أهمية العمل التنظيمي، وخلق القاعدة الجماهيرية التي توقد عمل السياسيين، وتبشر بمبادئهم التي تدعو إلى الحرية والديموقراطية، والمشاركة الشعبية، التي ناضلوا من أجل تحقيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهرة من النشطاء السياسيين الكويتيين انتسبوا إلى التنظيمات القومية العربية، ففي سنة 1935م تأسست حركة قومية سرية عربية في بيروت. وانتشرت فروعها في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والكويت وألمانيا وأميركا الشمالية"(29).
وضمت جداول أعضاء الحركة العربية السرية أسماء عدد من الكويتيين وهم : خالد سليمان العدساني من عمالة الكويت، عبداللطيف ثنيان الغانم من عمالة الكويت، عبدالله الصقر من عمالة الكويت، محمد الغانم من عمالة عدن، يوسف الغانم من عمالة الكويت"(30).
واستفاد الناشطون السياسيون الكويتيون من خبراتهم في الإنتساب إلى التنظيمات السرية العربية في إنشاء كتلة الشباب الوطني في العام 1938م.
يقول خالد العدساني عن نادي كتلة الشباب الوطني - ومعذرة للاستشهاد بنص طويل نظراً لأهميته - : " كانت الحركة الفكرية أبرز مزايا الحكم النيابي في الكويت وأَجلها، ذلك أن الكويتيين عاشوا ردماً من الزمن لا يستطيعون التعبير عن آرائهم وعنعناتهم الفكرية بالصراحة المطلوبة منهم، بينما تتنازع الشباب في الكويت عواطف جياشه طافحة بالوطنية القومية الصحيحة....
وكان الشباب الوطني الناهض من رعاة العهد، والمبشرين بمحامده ومزاياه قد دشنوا صرح الحرية بإفتتاح معهدهم الجميل "نادي كتلة الشباب الوطني"، تلك الكتلة المتآزرة، التي يشرف على تنظيمها فريق من الشباب وصفوتهم، وقد بلغ عدد المنتسبين إليها ما يقارب المائتي شاباً".. قسّموا أنفسهم إلى فرق ولجان لخدمة النهضة الحالية عن طريق بث الدعاية لغرس الروح العربية في السواد الأعظم من الأهالي وتعليم الأميين أصول القراءة والكتابة بفتح الصفوف الليلية مجاناً، والتطوع لخدمة المنكوبين، وجمع التبرعات الخيرية، وتوزيع الكساوي على الفقراء المعوزين. كما واظبوا على إقامة الحفلات الاسبوعية لنشر الثقافة، وتلقين الجمهور ما هية الحقوق الشعبية وأنظمة الحكم الديموقراطي، وغير ذلك من الأسباب النافعة التي لا يستطيع غير الشباب أن يضطلع بها.(31)
ويقول الأستاذ حمد الرجيب عن نشاط الكتلة الوطنية "وكان من نتيجة هذا المناخ الديموقراطي ظهور تكتلات .. بدأت كتلة جديدة في التكوّن كثمرة لهذا الانفتاح الديموقراطي ... كان سكرتير الكتلة هو أحمد زيد السرحان، وكان يعمل في نفس الوقت معاوناً لسكرتير المجلس التشريعي خالد العدساني. وكان لهذه الكتلة نشاط إجتماعي وثقافي وسياسي، فأصبحت تقيم الندوات، وتلقي الخطب"(32)
ويرى د. فلاح المديرس أن هذا التنظيم "كتلة الشباب الوطني" بمثابة واجهة سياسية لـ "الكتلة الوطنية التي تشكلت في بداية الثلاثينات وقادت الحركة الإصلاحية عام 1938م"(33)
دور الديوانيات الثقافية
تُعدُّ الديوانيات في الكويت أحد الروافد المهمة في التنمية الثقافية وتطوير الوعي السياسي؛ إذ يلتقي فيها المواطنون، ويتداولون شؤون حياتهم من جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسة.
وفي العام 1921م انطلقت من ديوان الحاج ناصر البدر الدعوة إلى إنشاء مجلس للشورى في الكويت.
وكان لديوان أسرة الصقر دور مهم في التوعية السياسية، إذ كانت تدور في ذلك الديوان الحوارات، وتُلقى الخطب التي تطالب بالإصلاح السياسي.
يقول الأستاذ حمد الرجيب "أذكر ونحن تلاميذ كيف تعلمنا السياسة، وتعرفنا على هموم الوطن وقضاياه. كنا نحضر "ديوانية الصقر"حيث كان دائماً فيها خطبٌ وحوارات سياسية، كما كنّا نسمع عبداللطيف الثنيان(34) وهو يخطب في ديوانية الصقر، ويطالب بالإصلاحات، بعد أن نصلي المغرب نذهب هناك، وكنّا معجبين بفصاحة النواب وشجاعتهم"(35).
وكانت ديوانيات بعض الأسر في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ممثلة للتيارات الفكرية السائدة آنذاك؛ فديوان أسرة الخالد يستضيف رجال الإصلاح مثل السيد رشيد رضا، والزعيم التونسي عبدالعزيز الثعالبي، والشيخ محمد الشنقيطي، فضلاً عن الاشتراك في الصحف التي تمثل تيارات الإصلاح.
أما علماء الدين من السنة والشيعة فكانت ديوانياتهم تستضيف العلماء للحديث في الأمور الدينية.
"وكان بعض علماء أسرة العدساني يستقبلون في ديوانهم طلاب العلم من السنة والشيعة، الذين يفدون إليهم من الأحساء لتدارس بعض القضايا الشرعية"(36).
ومن الديوانيات التي يلتقي فيها عدد كبير من الأدباء ديوانية السيد خلف النقيب. وذكر الأستاذ أحمد بشر الرومي من بين رواد ذلك الديوان الشاعر السيد مساعد الرفاعي الذي " يشن حملاته بقصائد يرتجلها في ذلك المجلس، فتنتشر في صباح اليوم الثاني، وكلها كانت رداً قاسياً على المتعصبين، فيرد هؤلاء المتعصبون بقصائدهم الركيكة والمضحكة أحياناً على السيد مساعد فيكيل لهم الصاع صاعين....
ودامت هذه الحرب الكلامية خمس سنوات تقريباً انهزم فيها المتعصبون هزيمة نكراء"(37).
وكان للحاج ملا حسين التركيت ديوانية يختلف إليها - في الغالب - علماء الدين، يقول الأستاذ عبدالعزيز حسين عن ديوانية والده "امتلك والدي الملا حسين عبدالله التركيت مكتبة زاخرة بكتب الدين والأدب والتاريخ ... وكان كلُّها تحت تصرف رواد ديوانية الوالد ... كانت ديوانية يومية عادية، وأخرى أسبوعية يجتمع فيها العلماء، ويتحدثون في الأدب والقصة والحديث والتفسير... وكان من روادها الشيخ عبدالله خلف الدحيان وأحمد الفارسي ومحمد بن جنيدل وشملان بن على آل سيف وبشر الرومي"(38).
في ظل الواقع الثقافي والفكري للمجتمع الكويتي في العقود الأولى من القرن العشرين، الذي حاولنا الاقتراب من صورته ولد الاستاذ عبدالعزيز حسين، ومجايلوه، وترعرعوا، ونما وعيهم، وأدركوا أهمية الجهود المضينة التي بذلها الرواد الأوائل للحفاظ على الهوية المدنية لمجتمعهم، ومقاومة ثقافة الغلو الديني، وتطوير النظام السياسي، وعقدوا العزم على أكمال المسيرة، كلَّ في مجال اختصاصه واهتمامه، ففي ميدان العمل الثقافي برز عدد كبير من الأدباء والمثقفين ذوي الفكر المستنير، منهم: عبدالله الجوعان 1911-1993م عبدالرزاق البصير 1915-1999م فهد العسكر 1917-1951م أحمد السقاف 1919-2010م عبدالعزيز حسين 1920-1996م حمد الرجيب 1922-1998م أحمد العدواني 1923-1990م عبدالمحسن الرشيد البدر 1927-2008م عبدالله أحمد حسين الرومي 1930-2008م.
وهناك من اختار ميدان العمل السياسي، ومنهم: الدكتور أحمد الخطيب 1927-2022م، جاسم القطامي 1927-2012م، يعقوب الحميضي 1931-2017م وغيرهم.
وإضافة إلى ما تقدم عرضه عن مشهد أو واقع المجتمع الكويتي الثقافي والفكري الذي نشأ فيه الأستاذ عبدالعزيز حسين ومجايلوه يجدر أن نشير إلى عامل آخر خارجي كان ذا تأثير في التكوين الفكري لشباب ذلك الجيل، إذ أتيحت لهم الفرصة للدراسة في مصر ولبنان والعراق وإنجلترا، الأمر الذي مكنهم من الانفتاح على عالم يموج بالتيارات الفكرية، والنضال السياسي، والحراك الثقافي الثري.
الهوامش والحواشي
1- تختلف الروايات في تحديد تاريخ تأسيس الكويت، فيذهب بعضها إلى اختيار العام 1022هـ 1613م، اعتماداً على تصريح الشيخ مبارك الصباح في رسائله إلى بعض ولاة البصرة، انظر: عبدالعزيز الرشيد - تاريخ الكويت الطبعة الثانية المحققة، اعتنى بنشره خالد عبدالقادر عبدالعزيز الرشيد ص45. وانظر : محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادت السنين 1/7ط ومحمد بن خليفة النبهاني - التحفة النبهانية 6/126.
ويعيد بعضهم تاريخ التأسيس إلى مطلع القرن الثامن عشر، إذ يربطون التأسيس بوصول الهجرة الكبيرة للعتوب إلى المنطقة.
2- انظر: د. خليفة الوقيان - الثقافة في الكويت: بواكير اتجاهات ريادات ص 21-30 ط6.
3- رسالة العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبداللطيف الأحسائي - مخطوطة.
4- خالد حمود السعدون : العلاقات بين نجد والكويت 1902-1922م ص 263 ط1.
5- تاريخ الكويت ص 438 ط2.
6- أمين الريحاني - ملوك العرب - ص663 ط8.
7- تاريخ الكويت - ص 137-138 ط2 كانت زيارة السيد رشيد رضا للكويت في العام 1912م.
8- محمد فريد وجدي - الذي يكفره الشيخ العلجي وصحبه مفكر إسلامي لـ جهود كبيرة في خدمة الإسلام. ومن مؤلفاته : تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنيّة - صفوة العرفان، وهو تفسير موجز للقران الكريم، الحديقة الفكرية في إثبات وجود الله بالبراهين الطبيعية - موسوعة القرن العشرين انظر: فهرس الاعلام للزركلي 6/329.
9- تاريخ الكويت ص 237 الحاشية.
10- المصدر السابق ص 137.
11- المصدر السابق ط1- 100-103 و ط2 المحققة ص 131-135.
12- المصدر السابق ص 237-239 ط2.
13- ديوان صقر الشبيب ص 210.
14- ديوان خالد الفرج - تقديم وتحقيق خالد سعود الزيد ص 109-110.
15- المصدر السابق ص 111-112.
16- د. خليفة الوقيان - الثقافة في الكويت - بواكبر - اتجاهات - ريادات ص121 ط6.
17- مذكرات خالد العدساني - مخطوطة - الورقة 4.
18- مجلة لغة العرب - الجزء الثالث - رمضان 1330هـ أيلول 1912م.
19- د. نجاة عبدالقادر الجاسم - الشيخ يوسف بن عيسى القناعي - دوره في الحياة الاجتماعية والسياسية ص 37.
20- ملوك العرب: ص 676 ط8.
21- مذكرات خالد العدساني - ورقة 5 - و : سجل الكويت اليوم ص 14-17.
22- ذكر سامي رفائيل بطي نقلاً عن والده ان مؤسس جريدة الدستور البصرية هو الأستاذ عبدالله الزهبر، ثم انتقل امتيازها إلى الاستاذ عبدالوهاب الطبطبائي. انظر سامي رفائيل بطي: صحافة العراق نتاج رفائيل بطي 1/52 وانظر: الثقافة في الكويت بواكير إتجاهات ريادات ص 85-86.
23- انظر جريدة القبس الكويتية - العدد الصادر في 11/12/2003م وأنظر أيضاً: تاريخ الكويت - ص 178-179 - ط 2 محققةَ.
24- د. بدر الدين الخصوصي - معركة الجهراء - ص 113 - ص319.وكانت قد جرت محاولة سابقة لتكوين مجلس معين أو منتخب في بداية حكم الشيخ سالم المبارك العام 1918م، ولكنها لم تنجح لأنها لم تأتي نتيجة رغبة كويتية، بل كانت بريطانية. ولذلك لم يتفاعل معها الكويتيون، بل أبدلوا بها اقتراحهم في العام 1920م الذي أشرنا إليه، يقول د. يوسف على المطيري "رأت السلطات البريطانية أن وجود الأقلية اليهودية في الكويت ربما يكون مدخلاً لتدخلها غير المباشر في شؤون الكويت الداخلية فنجد وثيقة بريطانية سرية كتبها مساعد المعتمد السياسي في الكويت في سبتمبر 1918 يتم الحديث فيها عن تكوين مجلس معين أو منتخب يتكون من الفئات المختلفة في المجتمع الكويتي أحد أعضائه يهودي، بعد عزل الشيخ سالم المبارك الصباح" اليهود في الخليج ص 189-190.
25- كذا في الأصل.
26- كذا في الاصل.
27- نُشر نص هذه الوثيقة وأسماء الموقعين عليها أول مرة في الطبعة الثالثة من كتاب الثقافة في الكويت بواكير اتجاهات ريادات، الصادرة في العام 2010م ثُم نُشرت صورة الوثيقة في الطبعة الرابعة من ذلك الكتاب الصادرة في العام 2010م أيضاً.
28- سيف مرزوق الشملان- من تاريخ الكويت ص 197- ط1.
29- شفيق جحا - الحركة العربية السرية - جماعة الكتاب الأحمر ص7.
30- المصدر السابق - ص439-440 - ذِكرُ (عدن) بعد اسم محمد الغانم يعني أنه كان مقيماً في مدينة عدن آنذاك. ومن المعروف أن للكويتين مكانة تجارية في كثير من المدن والمواني العربية والهندية.
31- نصف عام للحكم النيابي في الكويت - ص 23- ط1.
32- حمد الرجيب : مسافر في شرايين الوطن - ص 72.
33- انظر د. فلاح المديرس - ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت (1938م - 1975م) ص 6-10.
34- المقصود بهذا الاسم (عبداللطيف محمد ثنيان الغانم).
35- مسافر في شرايين الوطن ص75-76.
36- الثقافة في الكويت - بواكير - اتجاهات - ريادات - ص 197 ط6.
37- ديوان صقر الشبيب (المقدمة) ص 19-20.
38- تاريخ التعليم في الكويت - دراسة توثيقية - مجلدا ص 82. ويبدو أن مكتبة ملا حسين التركيت كانت تضم مخطوطات مما أُلِّف أو نُسخ في الكويت في زمن مبكر، ولعلها وصلت إليه من مكتبة والدة عبدالله بن حسين العوضي، ثم انتقلت منه إلى مكتبة ابنه عبدالعزيز. ومنها مخطوطة "موطأ الإمام مالك" التي نسخها مسيعيد بن أحمد بن مساعد بن سالم في جزيرة فيلكا الكويتية في العام 1094هـ - 1682م.
وكنت اطلعت على مخطوطة فقهية نسخها عبدالله بن حسين العوضي - جد الأستاذ عبدالعزيز حسين - وذكر أنها كتبت في بندر كويت.