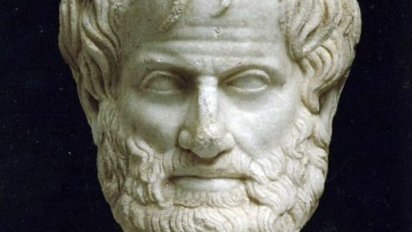في عالمٍ تتكاثف فيه الصور أكثر ممّا تتكاثف المعاني، ويعلو فيه الضجيج فوق الصوت الداخلي للإنسان، يعود "غي ديبور" ليهمس في أذن الحداثة بندائه القديم: لقد اختفى سؤال المعنى. لا لأنّه أُجيب عنه، بل لأنّه أُزيح جانبًا، وأُغرق في بحر المشاهد، وتوارى خلف واجهات العرض، والواجهات الزجاجيّة، والشاشات التي لا تنام.
"مجتمع المشهد" ليس مجرّد توصيف ثقافي، بل بنية وجوديّة جديدة، تتحوّل فيها الحياة إلى عرض دائم، والإنسان إلى متفرّج على ذاته. هنا لا نعيش العالم، بل نستهلك صوره. لا نختبر المعنى، بل نستهلك رموزه. تتحالف الرأسماليّة البيروقراطيّة مع منطق الاستعراض في علاقة عضويّة: الأولى تموّل، والثاني يضخّ المعنى المصنّع في وعي الجماهير، فينشأ نظام جديد لا يقوم على القهر الصريح، بل على الإغواء الناعم، وعلى وهم الحريّة، وعلى نشوة الاختيار.
في هذا العالم، لا يُقمع الإنسان بالقوّة، بل بالإقناع. لا يُخضع بالسوط، بل بالإعلان. لا يُسلب صوته، بل يُغرق في فائض الأصوات. يصبح الوعد بالتحرّر جزءًا من آليّة السيطرة نفسها. الحريّة هنا تُعرض كسلعة، والذات تُصاغ كهويّة قابلة للتسويق، والاختلاف يتحوّل إلى نمط جاهز للاستهلاك. وهكذا، كما يقول ديبور، تتحوّل الأيديولوجيا إلى نسيج خفيّ يغلّف الوعي، لا يُرى لكنّه يُعاش.
غير أنّ اختزال الفنّ والثقافة في كونهما مجرّد أدوات رأسماليّة يُفقدنا بعدًا أكثر عمقًا، فالعرض نفسه يحمل سؤال المعنى، حتّى وهو يطمسه. إنّه ليس فقط أداة تضليل، بل مرآة وجوديّة تعكس قلق الإنسان الحديث، خواءه، بحثه المستمر عن ذاته في صور لا تشبهه. المشهد، بهذا المعنى، ليس ترفيهًا بريئًا ولا خداعًا صرفًا، بل لغة جديدة يعبّر بها الوجود عن أزمته.
وهنا تستيقظ الفلسفة، لا كخطاب أكاديمي، ولا كنظام مفاهيمي مغلق، بل كممارسة حياتيّة، كفنّ للانتباه، كقدرة على الرؤية خلف الصورة، وسماع ما وراء الضجيج، ولمس ما وراء الواجهة. الفلسفة ليست تفسيرًا للعالم فحسب، بل تدريب على عدم الذوبان فيه. هي مقاومة ناعمة للابتلاع، ووعي بطيء في زمن السرعة، وتأمّل عميق في عصر السطح.
في زمن المشهد، تصبح الفلسفة ضرورة وجوديّة لا ترفًا فكريًا. لأنّ الإنسان الذي لا يفكّر يُدار، والذي لا يسأل يُوجَّه، والذي لا ينتقد يُشكَّل. والممارسة الفلسفيّة هنا لا تعني رفض التكنولوجيا ولا الهروب من العصر، بل تعني استعادة الذات داخل العصر، وبناء مسافة داخليّة بين الإنسان وما يُعرض عليه.
الفيلسوف ليس مصلحًا اجتماعيًا مباشرًا، لكنّه حامل عدوى الوعي. لا يغيّر العالم بقرارات، بل يغيّر نظرتنا إليه. لا يهدم البنى، بل يكشف تصدّعاتها. لا يصنع الثورات، بل يصنع العقول القادرة على تخيّلها. وكما قال نيتشه، فإنّ ما نسمّيه «العالم الحقيقي» ليس إلّا بناءً سرديًا، قصّة كبرى اعتدنا تصديقها.
لهذا، في مجتمع المشهد، تصبح الفلسفة فعل مقاومة رمزيّة، وممارسة تحرّر داخلي، وتمرينًا يوميًا على استعادة الإنسان لإنسانيّته. ليست ضدّ الصورة، بل ضدّ عبوديّتها. ليست ضدّ العرض، بل ضدّ تحوّله إلى بديل عن الوجود.
وهكذا، لا تعود الفلسفة ترفًا للنخبة، بل ضرورة لكلّ من يريد أن يبقى إنسانًا في عالم يتحوّل فيه الإنسان إلى محتوى، والوعي إلى بيانات، والحياة إلى عرض مستمر بلا توقّف.