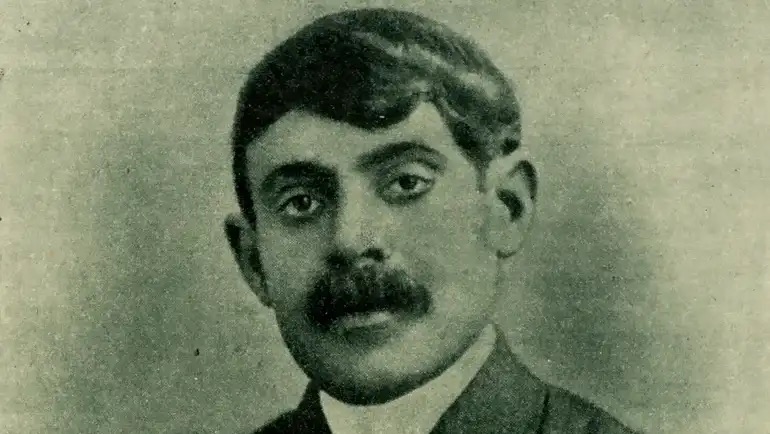في اللحظة التي بدأ فيها العالم الغربي يراجع يقينيات الحداثة، ويشكك في مركزية العقل، ويفكك السرديات الكبرى التي حكمت القرون الأخيرة، كان العقل العربي لا يزال يحاول أن يضع قدمه الأولى في طريق لم تُمهّد له بعد. تلك الفجوة الزمنية ليست مجرد تأخر تقني أو تفاوت في مستويات التنمية، بل هي في جوهرها فجوة معرفية، فكرية، نفسية، بلغة أدق، فجوة في الوعي التاريخي. ففي حين قطعت المجتمعات الغربية شوطًا في مساءلة الذات والواقع، لا يزال العقل العربي موزعًا بين دهشة الحداثة وخوف الموروث، بين الإعجاب بالنموذج الأوروبي والارتياب منه، بين التعلق بالهوية والخشية من الذوبان، بين الرغبة في التغيير والخوف من الفقد.
ولعل البداية المثلى لهذا التأمل أن نتساءل: ماذا نعني بالحداثة أولًا؟ لقد كانت الحداثة، كما عرفها الغرب، مشروعًا عقلانيًا ضخمًا تأسس على الإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة على العالم، وتفسير الظواهر، وإنتاج المعرفة، وفرض النظام. قامت الحداثة على مركزية العقل، وعلى فكرة التقدم، وعلى تجاوز المرجعيات الغيبية لصالح تفسير علمي ومنطقي للوجود. غير أن هذا المشروع، وبالرغم من ما أنجزه من تقدم علمي هائل، حمل في داخله بذور أزماته، إذ أنتج مجتمعات مادية، فردانية، نفعية، وشهد خلال القرن العشرين أكثر الحروب تدميرًا في التاريخ. جاءت ما بعد الحداثة كرد فعل على هذا المسار، لتعلن تفكك السرديات الكبرى، وانهيار المطلقات، وصعود النسبية، والشك، وتفكيك السلطة، سواء كانت دينية أو سياسية أو علمية أو لغوية.
هذا الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة لم يكن مجرد تغير في المصطلحات، بل زلزال فكري ومعرفي أعاد تشكيل الوعي الغربي من جذوره. والسؤال الآن: في أي موقع يقف العقل العربي وسط هذا التحول العنيف؟ الواقع أن الإجابة ليست سهلة، لأنها تقتضي مراجعة صريحة وعميقة لتجربة العقل العربي مع الحداثة نفسها قبل أن نتحدث عن تجاوزها.
إن من يتأمل السياق العربي يجد أن العلاقة مع الحداثة كانت ملتبسة منذ البداية. لم تكن الحداثة لدينا نتاج تطور داخلي طبيعي، بل جاءت غالبًا في صورة استعمارية، أو في صورة تقليد لنماذج جاهزة من الخارج. تلقيناها عبر النخبة المتعلمة، التي كانت معزولة عن البنية التقليدية للمجتمع، فظل التحديث شكليًا، محدودًا، موجهًا من الأعلى، يغير المظاهر ولا يمس الجوهر. لم تُطرح الأسئلة الحداثية في سياقها التاريخي، بل قُدمت كحلول سريعة لأزمات معقدة، وكان من الطبيعي أن يُقابل هذا المسار بالمقاومة، لا لأن المجتمعات العربية ترفض التغيير، بل لأنها لم تشارك في صياغته.
ولذلك بقي العقل العربي في مفترق الطرق، لا هو اندمج في مشروع حداثي أصيل ينبع من داخله، ولا هو احتفظ بمرجعيته التقليدية في صورتها الحية. أصبح العقل مأزومًا، مُشوّشًا، عاجزًا عن اتخاذ موقف واضح، تائهًا بين خطابين: خطاب يرفع لواء العودة إلى الأصول ويُدين الحداثة باعتبارها خيانة للذات، وآخر يتبنى الحداثة دون شروط، ويُدين الماضي باعتباره عائقًا أمام التقدم. كلا الخطابين قاصر، لأنهما لا يعكسان فهمًا حقيقيًا لتعقيدات الواقع، ولا يقدم أحدهما مشروعًا متماسكًا للمستقبل. وهنا يتجلى الإشكال العميق: هل يمكن للعقل العربي أن يتجاوز هذه الثنائية المفرغة؟ وهل يمكنه أن يتموضع بشكل مستقل في زمن ما بعد الحداثة؟
إن ما بعد الحداثة، بتفكيكها للمفاهيم الكبرى، تضع العقل العربي أمام تحدٍ مضاعف. فهو لم ينه بعد جدله مع مفاهيم الحداثة ذاتها مثل التنوير، والعقلانية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، فإذا به يواجه تيارًا جديدًا يُشكك في كل هذه المفاهيم نفسها. وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: نحن نواجه نقدًا لحداثة لم نختبرها بالكامل، ونُطالب بتجاوز منظومة فكرية لم نستوعبها بعد، وكأننا نُجبر على مغادرة بيت لم نسكنه أصلًا.
ولذلك فإن تعاملنا مع ما بعد الحداثة كثيرًا ما يكون سطحيًا، انتقائيًا، يقوم على استعارة المصطلحات دون فهم خلفياتها، وعلى تمجيد التفكيك دون بناء، وعلى تسويق الحيرة بدل مساءلتها. في بعض الأوساط الثقافية، أصبح الشك هو الموقف الوحيد، والنقد غاية في ذاته، والفوضى دليلاً على التحرر. لكن هذا النزوع ما هو إلا شكل آخر من الاغتراب، اغتراب عن الذات، وعن المجتمع، وعن الواقع، في لحظة نحن في أمسّ الحاجة فيها إلى تأسيس خطاب نقدي جاد، لا يقع في التبعية ولا ينزلق إلى الفوضى.
لعل أهم ما يجب أن يُقال هنا هو أن الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة لا يعني القطيعة مع كل ما هو عقلاني أو تنويري، بل هو دعوة لإعادة التفكير في الحدود التي رسمتها الحداثة لنفسها. وهذا ما يمكن أن يستفيد منه العقل العربي، بشرط أن يتم التفاعل مع هذه التيارات من موقع الفاعل، لا من موقع المتلقي. لكن هذا الشرط لن يتحقق ما لم يُعِد العقل العربي النظر في أدواته، ومناهجه، ومرجعياته، وما لم يخرج من أسر التقديس، سواء للتراث أو للغرب.
لكي نجيب بصدق عن سؤال "أين يقف العقل العربي؟"، علينا أن نعترف أولًا بأنه لا يقف في مكان واحد. فالعقل العربي ليس كتلة واحدة، بل هو فسيفساء من المواقف والتوجهات. هناك عقل محافظ، تقليدي، يخشى كل جديد ويقدّس القديم، وهناك عقل تغريبي، منبهر بالغرب إلى حد الذوبان، وهناك عقل نقدي، يحاول أن يشق لنفسه طريقًا ثالثًا، يدمج بين التحديث والأصالة، بين النقد والعمق، بين الشك والإيمان، بين التراث والتجاوز. هذا الأخير، وإن كان أقل حضورًا في المشهد العام، هو الذي نحتاج إلى تقويته، لأنه وحده القادر على التفاعل الخلّاق مع الأسئلة التي تطرحها الحداثة وما بعدها.
العقل العربي، في هذا الزمن المربك، يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن تلك التي امتلكها مفكرو النهضة في بدايات القرن الماضي، يوم تجرأوا على مساءلة التراث من داخل المنظومة الثقافية، ويوم طرحوا أسئلة لم يكن المجتمع مستعدًا لها بعد. اليوم، نحن في لحظة أكثر تعقيدًا، تتطلب شجاعة مضاعفة، لأن المساءلة لم تعد تخص الماضي فقط، بل تشمل المستقبل أيضًا. نحن بحاجة إلى عقل لا يكتفي بإعادة إنتاج الخطاب السائد، بل يعمل على خلخلته، وتفكيكه، وإعادة تركيبه، عقل لا يخاف من الحيرة، ولا يهرب من السؤال، ولا يكتفي بإجابات جاهزة تُعيده إلى دائرة الراحة الفكرية.
وإذا كان العقل الغربي قد انتقل إلى ما بعد الحداثة عبر نقد ذاته وتجربته، فإن على العقل العربي أن يخوض تجربته الخاصة، من دون استعجال، ومن دون تقليد، بل بروح نقدية عميقة تتعامل مع التراث والحداثة كمواد أولية لبناء مشروع جديد. مشروع لا يكرر ما مضى، ولا يُقلد ما هو قائم، بل يُبدع من قلب التوتر، ويُصوغ هوية فكرية نابعة من همومه وأسئلته.
ربما يكون السؤال الحقيقي ليس أين يقف العقل العربي، بل إلى أين يريد أن يذهب؟ هذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم. ولسنا مضطرين لا إلى العيش في الماضي، ولا إلى الانصهار في الآخر، بل يمكننا أن نختار طريقًا ثالثًا، صعبًا، لكنه ضروري: طريق الوعي، والتأمل، وإعادة البناء.