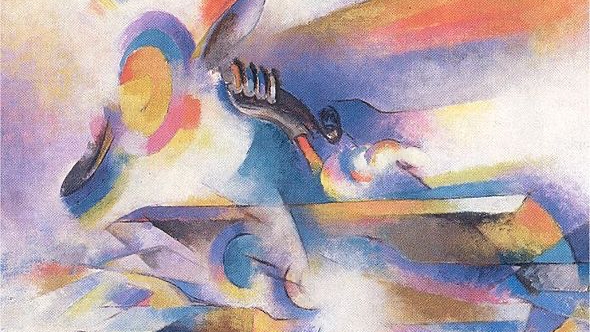دعونا نبدأ من مشهد يتكرر في قاعات الفلسفة ومنابر القانون، مشهد يطلّ علينا هذه الأيام بوقع أشدّ مرارة وإلحاحًا. أستاذ يضع أمام طلابه معضلة تكاد أن تُحاكي رعب الواقع: طائرة مكتظة بالركاب، اختطفها إرهابيون، وهي تتجه نحو هدف محتمل. هل يضغط القائد على زر إسقاطها ليُنهي حياة الأبرياء على متنها، أم يتركها تمضي إلى مصير قد يخلّف كارثة أعظم على الأرض؟ ليست المسألة تمرينًا أكاديميًا أو لغزًا فلسفيًا للتسلية، بل هي صورة مُكثفة لعالم يترنّح على حافة الهاوية، حيث تُصنع القرارات في لحظات خاطفة، وتزن العواقب بأثقال تَعدِل جبالًا.
في صمت قمرة القيادة المعبّأ بالذعر، يقف السؤال معلقًا مثل مقصلة على أعناق الضمائر: هل يُضغط الزر؟ هل تتحوّل الطائرة إلى تابوت من نار وحديد، أم تُترك لتجري نحو مصير ربما أشد فظاعة؟ هذه ليست لعبة أذهان، بل ارتجاج أخلاقي لعالم فقد بوصلته. الفلاسفة ينقبون في نصوصهم، والفقهاء يلوكون مصطلحاتهم، غير أن الجواب يظل هاربًا في عتمة طبيعتنا البشرية.
إننا لا نتحدث عن طائرات وإرهابيين وحسب، بل عن هشاشة التعايش الإنساني، وعن خوف يتزيّى بثوب "مصلحة الدولة"، وعن الشك الذي يتسلل ليلوث أبسط العلاقات. السياسة الدولية ليست إلا رقعة شطرنج حيث تُدار حيوات البشر كقطع صغيرة، تُضحى بها في رهان على ورقة مجهولة. العدو لم يعد يرتدي الزي الرسمي؛ بل صار يتخفّى بين الحشود، يتكاثر من رحم اليأس، ويذوب في تشققات المجتمعات. كيف تُبنى أسوار للأمن في وجه خصم لا مرئي، يتبدّل باستمرار ويتغذّى على الاحتقان؟
أما الاقتصاد، ذلك الإله الذي يقدسه العصر، فيرتجف من أقل اهتزاز. الأسواق تهوي، الأسعار تلتهب، والعمل يتبخر كما يتبخر السراب في الصحراء. الأمن الذي كان مرادفًا للطمأنينة صار وحشًا بألف رأس، يطلب المزيد من التضحيات، ويقايض الحرية بأوهام الأمان. والتكنولوجيا، التي وعدت بطمأنة البشرية، صارت سيفًا ذا حدين: طائرات مسيّرة، مراقبة جماعية، وذكاء اصطناعي قادر على أن ينقذ، لكنه في الوقت ذاته يمهد لرقابة وقمع غير مسبوقين. أين يتوقف الخط الفاصل بين الحماية والاستعباد؟
النفعية، بحساباتها الباردة للمنافع والخسائر، تدعونا لاختيار الأقل ضررًا. لكن التاريخ يحذرنا: كم من مرة برّر هذا المنطق فظائع لا توصف باسم "الصالح العام"؟ كم من إبادة وتطهير ودكتاتورية اتكأت على هذه الذريعة؟ حين تُختزل الضمائر في أرقام، يتحول الإنسان إلى مجرد وسيلة، وتذبح الكرامة فوق مقصلة المصلحة.
في المقابل، ترفع الديونتولوجيا صوتها: هناك حقوق غير قابلة للمساومة. الحق في الحياة، الكرامة الإنسانية، الحظر المطلق للتعذيب… مبادئ لا تنكسر حتى في أحلك الظروف. لكن، هل تكفي صلابة الأخلاق حين يطرق الشر الأبواب؟ الصرامة قد تشلّ الفعل كما تشلّه الجريمة، والتاريخ يخبرنا أن اللامبالاة لا تقل فتكًا عن الفعل الآثم.
أما العقد الاجتماعي، كما صاغه هوبز ولوك، فيعيدنا إلى أصل الاجتماع البشري: تنازل عن بعض الحريات مقابل حماية الدولة. لكن، ماذا لو أصبحت الدولة ذاتها تهديدًا؟ أية حقوق تبقى حين يُكسر العقد؟
ثم يطلّ رولز بنظريته في العدالة التوزيعية: كيف يُبنى مجتمع عادل فيما تتفاقم اللامساواة؟ كيف تُحفظ كرامة الضعفاء وسط طوفان الامتيازات والهيمنة؟
العولمة زادت الأمر تعقيدًا؛ قرار في أقصى الأرض يترك كوارث في طرف آخر. أزمات المناخ، جائحة كوفيد-19، حرب أوكرانيا… كلها شواهد على أن ترابط العالم يفرض أخلاقيات جديدة قائمة على المسؤولية العابرة للحدود.
في غرف الزعماء، وفي أروقة الأزمات حيث تُصاغ قرارات تمسّ ملايين الأرواح، يرنّ صدى هذه المعضلة. وعلى منصات التواصل، تُخاض حرب أخرى: كلمات كالرصاص، تعليقات مشبعة بالكراهية، وانحسار التعاطف في بحر من الغضب. القناع الرقمي حرر الألسنة لكنه حرّر معها وحشية كامنة، حتى بتنا جلادين افتراضيين لأنفسنا وللآخرين.
نحن لسنا شهودًا صامتين على انهيار العالم، بل مهندسون لمستقبل لم يُشيّد بعد. الشك قد يقودنا للتساؤل، لكن التعاطف قد يقودنا للفهم، والعدالة يمكن أن تلهمنا أن نتمسّك بالكرامة الإنسانية كآخر حصن لنا. هناك، في قلب هذه المقصلة الأخلاقية، يظل سؤالنا معلقًا: كيف نصنع غدًا لا يُسحق فيه الإنسان تحت عجلات الضرورة، ولا يُضحى به على مذبح الخوف؟